نظرة إلى الجنون.. بين الموروث الإسلامي والغربي
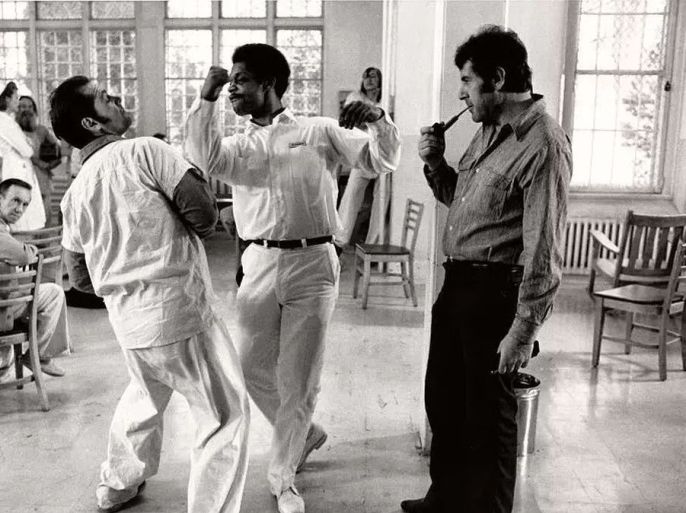
في حفل للمريضات العقليات في مصحة سالبيتريير يتذكر الكاتب ماكسيم دي كامب فيقول: مرة حضرت حفلا تنكريا للمريضات عقليا حيث فُتح لهن متجر ملابس، وتنكرت كل منهن على ذوقها في زي ماركيزة أو بائعة حليب أو مهرجة، كانت إحداهن تحوم حول الرجال، والأخرى تدق على البيانو، بينما لبست إحداهن قبعة ذات ريشة كرمز للقيادة.
وفي عام 1892م قدمت زوجة أحد المرضى العقليين شكوى للمسئولين ضد "حفلات المجانين" تقول فيها: سينظم في الرابع عشر من (يوليو/تمّوز) حفل للمرضى والمريضات عقليا للترفيه عن بعض المرضى المميزين، وهم بالتأكيد أكثر رقيا والأكثر جنونا بين نزلاء المصحة، وأنت تدرك ياسيدي مدى ألمي بل وغضبي، حيث إن زوجي نزيل في تلك المصحة للأمراض العقلية، إني أعترض بشدة على كل من يريدون أن يجعلوا من هؤلاء التعساء، ومن زوجي على الأخص أضحوكة ومحطًا لسخريتهم، وأرفض أن يكون زوجي من بين الحاضرين لهذا الحفل الشنيع[1]!
ربما يبدو الحديث عن الجنون في بعض الأوساط حالة من الترف الفكري، إلا أن تحليل البنية الاجتماعية التي تنظر للجنون يعكس نمط التفكير الذي يتم النظر فيه للشرائح الاجتماعية، وباعتبار الجنون حالة اجتماعية، فإن تحليلها والتعامل معها بإمكانه أن ينبئنا عن القيم التي يحملها مجتمع دونا عن آخر، فكيف نظر الفقهاء الإسلاميين للجنون وتعاملوا معه، وكيف نظر المجتمع الغربي ومفكريه تاريخيا لذات الحالة من الجنون وكيف تعاطوا معها؟

"رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق"[2].
هذا الحديث صار أصلا من أصول تشكيل العقل العربي والإسلامي تجاه قضية الجنون برمتها، باعتباره "لا حرج عليه"، أو هو خارج إطار الوعي بالكلية. وهنا يتجلى البُعد الأخلاقي والقيمي في بعض المؤلفات التي تناولت هؤلاء المجانين والحمقى وأخبارهم، فحين تُطالع ما كتبه ابن الجوزي، على سبيل المثال، في مقدمة كتابه "أخبار الحمقى والمغفّلين" فإنه يكشف لك أن هناك أسبابًا جوهرية دفعته لتأليف هذا الكتاب الذي قد يُستغرب أن يصدر من مثله، وهو الإمام الفقيه المؤرخ الأصولي الكبير الذي عاش في بغداد في القرن السادس الهجري/الحادي عشر الميلادي.
يوضح ابن الجوزي أسبابه الثلاثة التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب يقول: "آثرتُ أن أجمع أخبار الحمقى والمغفلين لثلاثة أشياء؛ أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وُهب له مما حرموا منه، فحثّه ذلك على الشكر. والثاني: أن ذكر المغفّلين يحثّ المتيقظ على اتقاء أسباب الغفلة إذا كان ذلك داخلاً تحت الكسب وعامله فيه الرياضة، وأما إذا كانت الغفلة مجبولةً في الطباع، فإنها لا تكاد تقبل التغيير. والثالث: أن يُروّح الإنسانُ قلبه بالنظر في سير هؤلاء المبخوسين حظوظاً يوم القسمة، فإن النفس قد تمل من الدؤوب في الجد، وترتاح إلى بعض المباح من اللهو"[3].
فإذا جاءت مؤلفات الآداب على أخبار هؤلاء كلونٍ من ألوان الفكاهة والتسلية، أو التأمل واتخاذ سبيل الموعظة لشكر النعم التي يحظى بها العاقل الراشد؛ فإن المدونة التشريعية الفقهية قد تناولت وجودهم وحقوقهم الجسمانية والنفسية والمالية بشيء من التفصيل.
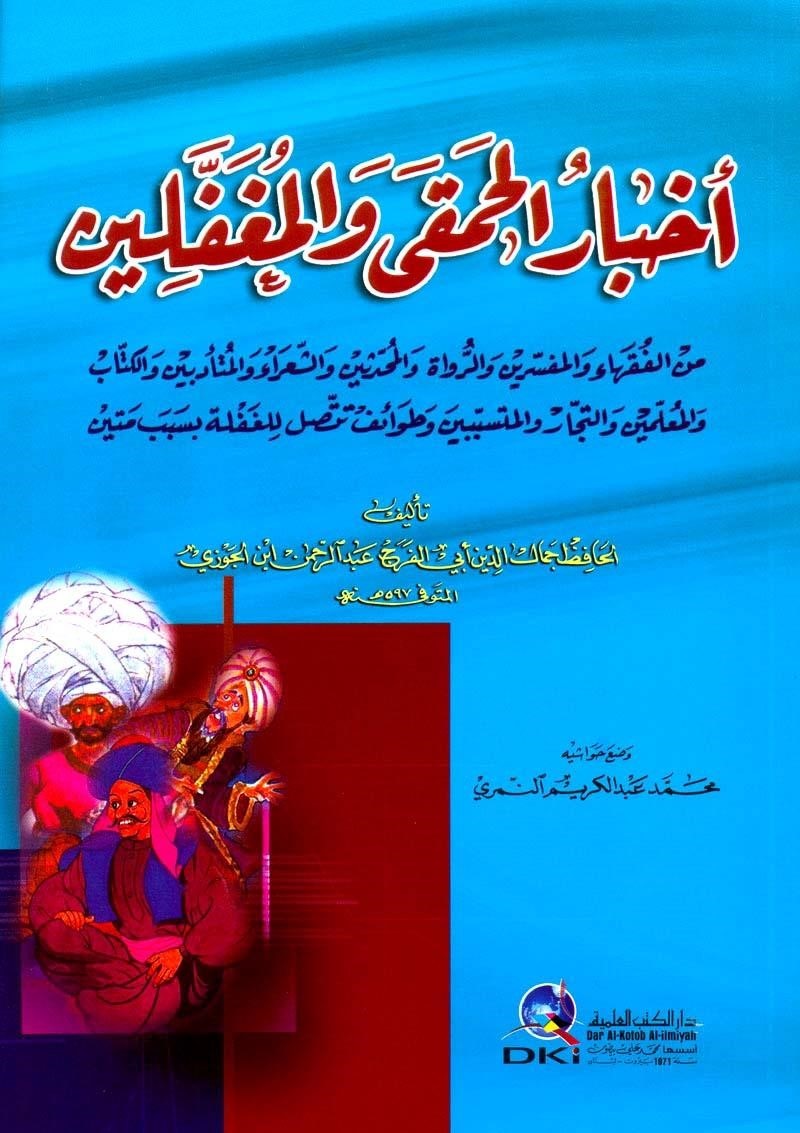
ففي كافة المذاهب الفقهية وفي مسائل الفروع عند الحديث عن التكليفات التي ألزم بها الله تعالى عباده فإن الفقهاء كلهم مجمعين على سقوط هذه التكليفات عن الصبي غير الراشد حتى يصل إلى سن البلوغ والعقل وعن المجنون أيضا، ولهم حديث مفصّل عن ماهية المجنون وصفاته وأنواعه بين المطبق والمتقطع والكلي، فضلا عن تفريقهم بين العته والسفه. فعلى سبيل المثال لا يُقبل البيع من المجنون كما يقول الإمام الكاساني الحنفي "لأن أهلية المتصرّف شرط انعقاد التصرف. والأهلية لا تثبتُ بدون العقل، والعقل لا يثبتُ الانعقاد بدونه"[4]. وبهذا يُحفظ مال المجنون من التلف والضياع.
على الجانب الآخر، حفظ للمجنون والمريض العقلي حقه الاجتماعي كاملا، ففي فقه الشافعية نجد حديثًا عن حق المرأة المجنونة في الزواج، وهذا الحق عندهم دائر بين الإمكان والاستحباب في بعض الأوقات والوجوب في أوقات أخرى إذا مسّت الحاجة إليه كما يقرر الإمام الجويني الشافعي في موسوعته "نهاية المطلب" الذي يرى أن يكون ولي أمر المجنونة في هذه الحالة غير مقصور على الوالد أو الأخ فقط وإنما يتدخل الوالي أو السلطان ويشترك في هذه الولاية "لقصور شفقه الأخ، وامتناع الطلب (أي طلب الزواج) من المجنونة"[5]. وبهذا يُحفظ حق المرأة المجنونة في الزواج حتى لو لم تكن قادرة على التعبير عن هذا الطلب.

على المستوى العلاجي أفردت مصنفات الطب والعقاقير في التراث الإسلامي حديثا طويلا عن الأدوية التي تصلح لعلاج المصابين بالجنون منها الفصد، والفصد كان مشهورا كعلاج عالمي في الحضارتين العربية والأوروبية على السواء، فضلا عن بعض العقاقير المستخلصة من النباتات الطبية أثناء عملية الفصد. وفي هذا يقول طبيب الحضارة العباسية الشهير أبو بكر الرازي (ت 313هـ/925م) موجها حديثه للأطباء المتعلمين في عصره: "افصِد هؤلاء واحقنهم وضمد الشراشيف بعد اليوم السابع بالأضمدة الملينة المهيأة من بزر الكتّان ونحوه، وعلاج المجنون السبعي بعلاج الماليخوليا أن يُوضع على رؤوسهم خل خمر، ودهن ورد، ويفصد لهم عروق الآس"[6].
في دمشق على سبيل المثال كانت المستشفى "البيمارستان" النوري الذي أنشأه السلطان العادل نور الدين محمود في القرن السادس الهجري/الحادي عشر الميلادي واحدا من أشهر المستشفيات العالمية في عصره، وفيه تم إنشاء قسم خاصّ بالمرضى النفسيين[7].
كانت الدولة الزنكية ومن بعدها الأيوبية تعين أمهر وأشهر الأطباء لهذه المجمعات الطبية، ومنهم الطبيب مهذب الدين الدخوار الذي تناولناه في تقرير سابق، كان الدخوار يتابع بصورة يومية القسم المخصص بالمرضى النفسيين ومنهم المجانين، وكان الدخوار مشهورًا بتطوير أبحاثه العلمية، وتدوين ملاحظاته التي كان يجريها يوميا ويستفيد منها على مرضى المستشفى النوري. من هذه الأدوية ماء الشعير الذي كان يقدم لهؤلاء، لكنه بعد دراسات مكثفة رأى أن يضاف إليه جرعة معينه من نبات الأفيون، وبدأ في تجربة هذا العلاج الجديد على أحد المرضى، وفي ذلك يقول ابن أبي أصيبعة الطبيب والمؤرخ والشاهد على ذلك: "فصلح ذلك الرجل وزال ما به من تلك الحال"[8].
"إن أولئك الذين تدمّرهم الآلهة تجعلهم في البداية مجانين".
(يوربيدس)
ساد الاعتقاد في العالم الإغريقي القديم أن الجنون ناتج عن لعنة الآلهة أو صراعها في جسد الإنسان وروحه، فمن كان مريضًا بالصرَع يكون مسكونًا بالشيطان أو الروح الشريرة التي تصطرع مع جسده وروحه، فإذا تصرّف المصاب مثل نعجة أو صرّ على أسنانه بشدّة أو حدث له تشنّج في شقه الأيمن فإن هيرا، أم الآلهة، هي المسئولة عن ذلك. وإذا رفس المصاب برجليه وعلا الزبد فمه، فإن إيرس، إله الحرب هو المتسبب في هذا وهلم جرا[9]. وفي الغالب كانت تُجابه هذه الاضطرابات الصحية بالصلوات والتعويذات والأضحيات التي تقدّم في المعابد إلى إله الطب والشفاء "إسكليبيوس"[10].

ولم يختلف التصور اللاهوتي المسيحي عن الأغريقي كثيرا إلا في طبيعة الآلهة، فتبعا لهذا اللاهوت كان "الخبل العقلي" أمرًا شريرًا دبّر له الشيطان وأذاعته الساحرات والهراطقة، وفي كتابه "تشريح السوداوية" 1621م، رأى روبرت بيرتون رئيس كلية أكسفورد أن "الشيطان مسببًا للأسى والانتحار"[11]. ومع ذلك فقد كانت هناك محاولات عديدة لمساعدة المجانين علاجيا ونفسيًا، وذلك بإنشاء بيوت مخصصة لهم، أو عنابر فردية لهم في بعض المشافي هنا وهناك، فضلا عن انتشار العلاج بالأعشاب واللبخات والأفيون لتهدئة هؤلاء المرضى، لكن ثمة نوع آخر من العلاج كان موجودًا وبكثرة.
هذا العلاج تمثّل في زيارات "الحج" للأماكن المسيحية المقدّسة، حيث كان يجري اصطحاب المجانين إلى بلدية هابر، في شمال فرنسا من أجل التضرع إلى القديس "أكير"، وقد أدى نجاح رحلات الحج إلى مزارات القديسين اعتبارًا من القرن الثاني عشر الميلادي إلى إنشاء مشفى لعلاج المجانين سنة 1218م، وكان المجانين يأتون إلى بلدية سان مينو في فرنسا طلبا لشفاعة القديس مينو، وإلى بلدية سان ميان للتضرع إلى القديس ميان، وإلى بلدية لوكمينيه في منطقة بريتاني بفرنسا أيضا للتضرع إلى القديس كولومبان[12].
هناك بعض المصادر التاريخية التي تشير إلى وجود بعض حالات الشفاء من الجنون والخبل العقلي نتيجة "معجزات القديسين"، لكن هذه المصادر ذاتها تكشف لنا أن الأمور لم تكن تسير دومًا على هذا النحو، فها هو أحد المرضى المسمى بيير ناجو الذي تم اصطحابه في عام 1384م إلى دير القديس سيفيه حتى يقضي فيه تساعيه وشفائه، ذكر أنه "ظل مربوطًا لمدة تسعة أيام وكان يصرخ ويصيح لدرجة أنه لم يكن ممكنًا أن ينعم أي إنسان بالهدوء والراحة في الدير المذكور طوال مدة إقامته به، ورغم ذلك لم ينل هذا المجنون الشفاء قط ولم تتحسن حالته، بل على العكس، زادت حالته سوءًا، وبدأ يقوم بتصرفات جنونية لم يكن يفعلها من قبل"[13].
وحين شرعت أوروبا في إنشاء المستشفيات العامة في القرن السابع عشر الميلادي؛ تجسّدت فيها مفهوم الحجز بامتياز، سجنا وإصلاحية ومأوى ومارستانًا لهؤلاء المجانين، أي أداة قمع تقوم بكل شيء عدا العلاج، فقد أُنشئ في بداية الأمر في فرنسا بأمر ملكي لمحاربة العطالة والتسكع والتسول في الشوارع وأبواب الكنائس، ليصبح بعد ذلك غولا هائجًا سرعان ما ابتلع في طريقه كل شيء. ابتلع كل الذين يوجدون على جنبات خط رفيع لا يُرى، رسمته المصالح الخاصة والعامة: مصلحة العائلة، ومصلحة المجتمع، ومصلحة الدولة[14].
لذلك؛ رأى ميشيل فوكو في كتابه المهم "تاريخ الجنون" أن الممارسات التي كانت تتم تجاه المجانين في العصور الوسطى والكلاسيكية وحتى بدايات العصر الحديث في أوروبا كانت تنم عن أشكال لا أخلاقية من صور المراقبة وربما العقاب لا العلاج. يقول: "إذا كان لبعض المجانين في بعض المستشفيات أماكن خاصّة بهم تمنحهم وضعًا طبيًا، فإن أغلبهم كانوا في دور الحجز يعيشون كما يعيش الخاضعون للإصلاح (المجرمين)… إن الأمر لا يتعلق سوى بمراقبة طبية عن بُعد، لم تكن الغاية منها معالجة المحجوزين، بل الاعتناء بهؤلاء الذين يُصابون بمرض ما، وهو دليل كاف على أن المجانين لم يُنظر إليهم بصفتهم مرضى لأنهم مجانين"[15]. وإنما نظر إليهم باعتبارهم عبء/شر على الدولة والمجتمع.
|
ظلت أطروحة المجنون الشرير سائدة في المجتمع الغربي حتى القرن التاسع عشر، وحينها فقط بدأت المؤسسات الطبية في الظهور لتستعيد كل التصنيفات القديمة وتعيد صياغتها استنادًا إلى علم وضعي يلغي من حسابه كل ما له علاقة بالأخلاق والدين وأحكام المجتمع؛ ليصبح المجنون أخيرًا "مريضًا عقليًا" يحتاج إلى العلاج والمساعدة، إلى أن يسترد لسانه ولغته وملكوته[16].
لم يكن من المستغرب أن يكون "تاريخ الجنون" لفوكو سابقا على بعض أعماله القيمة الأخرى مثل "المراقبة والعقاب"، وربما استلهم من تاريخ الجنون أطروحة المراقبة، وهي تجربة فريدة غاصت في عالم العصور الكلاسيكية الأوروبية بمواردها ومصادرها المختلفة التاريخية والطبية والاجتماعية والأساطير والكيمياء وغيرها لتخرج لنا في نهاية المطاف بنتيجة مفادها أن سحق المهمشين من الضعفاء والمرضى والتحكم فيهم كان ينطلق من مفهوم "المصلحة العامة" هذا المفهوم الذي كان ولا يزال أساسا أخلاقيا لتصور الدولة لنفسها ولرعيّتها وحقها في المراقبة والتنميط والعقاب!ّ
على الجانب الآخر نظرت الحضارة الإسلامية إلى الجنون باعتباره مرضًا نفسيًا وعضويًا؛ لصاحبه الحق في العلاج والحياة وحفظ حقوقه، وجعلت الناظر على شؤونه أولياء أمره فإن قصّروا في شأنه أوكل إلى الوالي ثم إلى المنظومة الطبية والنفسية التي شرعت في إنشاء أقسام خاصة للمجانين في مستشفيات المدينة التي كانت في الغالب في مراكز المدن الإسلامية وليست على الأطراف أو في الصحاري؛ اعترافًا منها بأن الجنون مرض لصاحبه الحق في العلاج والحياة.

