"رجل البنتاغون المفضل".. لهذه الأسباب لن يستطيع بايدن الضغط على السيسي


منذ إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، سادت حالة من القلق وعدم الارتياح أوساط النظام المصري، قلق قابله موجة تفاؤل حذرة لدى معارضي النظام. فعلى جانب الحكومة، يخشى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورموز نظامه، ليس فقط من فقدان حليفهم الموثوق به في البيت الأبيض "دونالد ترامب" الذي لقَّب السيسي بـ "ديكتاتوره المفضل"، ولكن أيضا من غموض موقف الإدارة الجديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع القاهرة، خاصة في ضوء التصريحات اللاذعة الصادرة عن بايدن وفريقه بشأن وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الأراضي المصرية.
على الجانب المقابل، يمتلك المعارضون المصريون بمختلف أطيافهم أسبابهم الخاصة للتفاؤل بقدوم بايدن، فقد شغل الرئيس المنتخب منصب نائب الرئيس في الإدارة الديمقراطية السابقة تحت قيادة باراك أوباما، التي تفاعلت بشكل "إيجابي" مع دعوات تعزيز الديمقراطية التي اجتاحت المنطقة إبان الربيع العربي، ودعمت المطالب الشعبية لإنهاء حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وعلى الرغم من أن بايدن لم يُقدِّم تعليقات مفصلة حول سياسته تجاه الشرق الأوسط -ومصر على وجه الخصوص- خلال حملته الانتخابية، فإن وعوده المتواترة بتبنّي سياسة خارجية تقوم على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أسهمت في تعزيز ذلك الشعور بالأمل.
هذه المشاعر الإيجابية تَنامت مع توالي التصريحات الصادرة عن بايدن ورموز إدارته، وعلى رأسها التغريدة التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية في يوليو/تموز الماضي، وأكّد خلالها أنه لا ينوي "منح المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل"، وذلك في معرض تعليقه على حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التي استهدفت نشطاء حقوق الإنسان في مصر، فضلا عن الدعوات المتكررة الصادرة عن النواب الديمقراطيين في الكونغرس للضغط على نظام السيسي، وأهمها ما وقع في أغسطس/آب الماضي، حين دعا 40 عضوا في الكونغرس -معظمهم من الديمقراطيين- وزير الخارجية مايك بومبيو إلى ربط العلاقات الدفاعية مع مصر بمدى استجابة القاهرة لدعوات تحسين حالة حقوق الإنسان، والرسالة اللاحقة التي وجَّهها 56 من النواب الديمقراطيين في أكتوبر/تشرين الأول إلى السيسي ودعوه خلالها للإفراج عن السجناء السياسيين.
Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik
— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020
لكن ما يُطمئن السيسي ونظامه، ويُكدِّر صفو معارضيه في الوقت نفسه، هي الحقائق التي يدركها الكثيرون اليوم جيدا حول طبيعة العلاقات المصرية الأميركية، وعلى رأسها أن هذه العلاقات لا تُدار من خلال التصريحات التي يُطلقها المرشحون خلال الحملات الانتخابية، وأن الروابط الثنائية بين القاهرة وواشنطن تُعَدُّ إحدى ركائز السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بغض النظر عن هوية ساكني البيت الأبيض وقصر الاتحادية، وحتى بغض النظر عن الموقف الشخصي للرئيس الأميركي تجاه الطريقة التي تُدار بها شؤون السلطة في مصر.
وبخلاف ذلك، تستند النظرات المُغرقة في التفاؤل بشأن تأثير الإدارة الديمقراطية الجديدة على السياسة في مصر إلى تقدير مبالغ فيه حول حجم النفوذ الذي تمتلكه واشنطن على صُنَّاع السياسة في العاصمة المصرية، فعلى الرغم من أن قدوم بايدن للسلطة من المرجح أن يُضيِّق هامش الحرية الواسع الذي يتمتع به نظام السيسي، داخليا وخارجيا، عبر زيادة تكلفة توسيع سياسات القمع، فإنه من غير المرجح أن يؤثر بشكل جوهري على مسار العلاقات المصرية والأميركية، فضلا عن أن يُحدِث فارقا جوهريا في الطريقة التي تُدار بها أمور السياسة المصرية.


تأرجحت مصر الحديثة طويلا، منذ استقلالها، بين الاعتماد على الغرب بوصفه ضامنا أمنيا واقتصاديا وبين ميولها القومية المتأصِّلة التي دفعتها للتقارب مع السوفييت. ولكن منذ توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل في أواخر السبعينيات، وتخلّي الرئيس المصري أنور السادات عن سياسات العهد الناصري، أصبحت واشنطن الشريك الإستراتيجي الأهم للقاهرة، فيما تحوَّلت الأخيرة، بفضل وزنها الديموغرافي، وموقعها الإستراتيجي على مفترق طرق تجارة النفط بين الشرق والغرب، وأيضا وجودها في قلب منطقة الشرق الأوسط صاحبة الأهمية الكُبرى في السياسة الأميركية، تحوَّلت إلى أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وبفضل هذه الشراكة، أصبحت مصر رابع أكبر مُتلقٍّ للمساعدات الأميركية في العالم. وكما تُشير البيانات الصادرة عن الخارجية الأميركية فإن مصر تلقَّت ما يعادل 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، منذ عام 1980. وقد أسهمت برامج المساعدات، مع ما صاحبها من توريدات الأسلحة والمناورات المشتركة وبرامج التأهيل والتدريب وحتى العمليات العسكرية، أسهم كل ذلك في تعزيز العلاقات المؤسسية بين واشنطن والقاهرة على مستويات الأمن والاستخبارات والدفاع، وساعدت في دمج الجيش والمؤسسات الأمنية المصرية ضمن المنظومة الإستراتيجية الأميركية، وحصّنت العلاقات المصرية الأميركية من التقلبات السياسية في كلا البلدين.
في الوقت نفسه، لعبت العلاقة بين القاهرة وتل أبيب دورا مهما في تعزيز تحالف الأولى مع واشنطن. ولمّا كان البلدان لم يتورّطا في أي مواجهات ضد بعضهما بعضا منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد، فإن الأميركيين ظلّوا يعتبرون هذه الاتفاقية إنجازا محوريا لا يمكن التضحية به، ونموذجا يُحتذى به لسائر الدول العربية المتوجِّسة من إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، وعاملا حاسما في ضمان أمن دولة الاحتلال لا سيما على حدودها الغربية مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وبجانب ذلك، فقد لعبت مصر في مناسبات عدة دور الوسيط بين حماس وسائر الحركات الفلسطينية وبين إسرائيل، ما ساعد على نزع فتيل التوترات وحماية المصالح الأميركية في المنطقة، فضلا عن قيام القاهرة وتل أبيب بتطوير علاقات أمنية واستخباراتية -بل واقتصادية- خاصة خلال العقد الأخير بفعل المخاوف المشتركة من تأثير الانتفاضات العربية وصعود الإسلاميين.

وحتى في الأوقات التي شهدت خلالها العلاقات السياسية بين واشنطن والقاهرة توتُّرا ظاهرا كما حدث إبان تظاهرات الربيع العربي التي أطاحت بحسني مبارك، بسبب موقف الإدارة الأميركية الداعم ظاهريا للمطالب الشعبية، حتى في تلك الأوقات حافظ البلدان على التواصل بينهما من خلال القنوات الخلفية، ولم ينقطع التنسيق بين البنتاغون والجيش المصري للحظة واحدة بعد الإطاحة بمبارك، وهو ما ينطبق أيضا على حقبة ما بعد الانقلاب العسكري المصري منتصف عام 2013، حين شهدت العلاقات السياسية بين البلدين توتُّرا بسبب موقف إدارة أوباما المُتحفِّظ تجاه استيلاء الجيش على السلطة واستخدامه القوة الغاشمة ضد المدنيين، بينما استمرت العلاقات العسكرية والاستخباراتية قائمة خلف الكواليس عبر خط ساخن يربط بين البنتاغون ووزارة الدفاع المصرية.
في عهد ترامب، جرى تجاوز جميع هذه الخلافات السياسية العارضة، ووصلت العلاقات بين القاهرة وواشنطن إلى درجة غير مسبوقة من الانسجام والتعاون، حيث أقام السيسي وترامب علاقة شخصية قوية تطوَّرت بشكل أساسي بسبب موقف ترامب المناهض للإسلام السياسي وجماعة الإخوان، وهو موقف يتطابق تماما مع موقف القاهرة والسيسي تحديدا، فضلا عن لا مبالاة ترامب الواضحة تجاه مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا مبالاة ترجمها السيسي إلى ضوء أخضر لتعزيز سياسات القمع.
وبجانب ذلك أطلق ترامب يد السيسي في التصرُّف بحرية في جميع الصراعات التي تمتلك فيها القاهرة مصالح أو رؤية خاصة، بما يشمل السباق على الطاقة في شرق المتوسط، ودعم خليفة حفتر في ليبيا على حساب الحكومة المُعترَف بها من قِبَل المجتمع الدولي والولايات المتحدة نفسها، وحتى في مسألة الحدود مع السودان وحوض النيل، والمفاوضات حول حصص المياه مع إثيوبيا، لدرجة أن ترامب منح القاهرة ضوءا أخضر للتحرُّك بحرية أكبر في ملف سد النهضة، على الرغم من أن القاهرة لم تغتنم هذه الفرصة بشكل جيد.
في مقابل هذه التسهيلات، منح السيسي ترامب دعما حاسما في تمرير خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة باسم صفقة القرن، على الرغم من انحيازها الفاضح ضد الحقوق الفلسطينية، وعزّز السيسي التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة في مجال "مكافحة الإرهاب"، وقفز بالعلاقات الأمنية بين مصر وإسرائيل إلى مستوى غير مسبوق، وانخرط في جميع التحالفات الإقليمية التي سعت واشنطن إلى تأسيسها، وبدا أن صفقة مقايضة التعاون الأمني والسياسي مقابل تجاهل واشنطن للشأن الداخلي في مصر هي الصيغة المُثلى لإدارة العلاقات المصرية الأميركية من وجهة نظر كلٍّ من ترامب والسيسي.

بعبارة أخرى، كان ترامب من وجهة نظر السيسي هو الساكن النموذجي للبيت الأبيض، لذا فإن رحيله سيُمثِّل خسارة بالنسبة للرئيس المصري أيًّا كانت هوية مَن يخلفه، خاصة إن كان خَلَفُه رئيسا شغل منصب الرجل الثاني في إدارة يعتبرها النظام العسكري المصري الأسوأ بالنسبة إليه، وهو أيضا مرشح قام بحشو حملته الانتخابية بالانتقادات الحادة لذلك النظام، ونتيجة لذلك فإن المتابع لتغطيات الصحافة والإعلام في مصر لفوز بايدن الانتخابي سوف يلمس بسهولة مدى القلق والارتباك الذي أصاب العاصمة المصرية بعد إعلان هزيمة ترامب.
في أدنى الأحوال، يخشى نظام السيسي من أن انتخاب بايدن سيعني عودة العلاقات المصرية الأميركية إلى الأجواء الباردة التي سادت خلال ولاية أوباما. في ذلك الوقت، لم يدعُ أوباما السيسي لزيارة البيت الأبيض، واعتبرت إدارته وصول الأخير للسلطة في مصر انقلابا عسكريا ضد حكومة مُنتخَبة بشكل شرعي، على الرغم من أن إدارة أوباما لم تُسمِّه كذلك بشكل صريح، كما جمّدت 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لما يقرب من عامين، وعلّقت التدريبات العسكرية المشتركة معها في محاولة للضغط عليها لاستعادة العملية الديمقراطية التي انهارت في ظل نظام السيسي. وتتفاقم هذه المخاوف أكثر بالنظر إلى أن العديد من الشخصيات البارزة في إدارة أوباما من المرجح أن يتولّوا مناصب رئيسة في الإدارة الجديدة، بما في ذلك بعض الذين اتخذوا موقفا قويا ضد مصر.

وحتى لو افترضت دوائر السلطة في نظام السيسي أن براغماتية بايدن المعروفة وتحفُّظه السياسي سوف يمنعانه من اتخاذ مواقف راديكالية ضدها، فإن القاهرة لديها هواجس من أن يستسلم بايدن لضغوط اللوبي الديمقراطي التقدُّمي في الكونغرس، وهو لوبي يُكرِّس جزءا كبيرا من جهوده لتوجيه السياسة الأميركية نحو الاهتمام برعاية الديمقراطية وحقوق الإنسان، لوبي يضم أمثال السيناتورات كريس ميرفي وباتريك ليهي وتومي بالدوين وإليزابيث وارن، والنواب توم مالينوفسكي ورو خانا وإلهان عمر وغيرهم، وهؤلاء يضغطون بشدة من أجل ربط المساعدات الأميركية لمصر بتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
يمتلك نظام السيسي أيضا هواجس حول إمكانية قيام إدارة بايدن بفتح قنوات اتصال مع المعارضة المصرية في الخارج، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين مع ممارسة ضغوط لدمجهم في الحياة السياسية، أُسوة بما حدث في عهد أوباما، على الرغم من أن هذا السيناريو يبقى غير مرجح اليوم إلى حدٍّ كبير. وفي حين أن الأسباب التي تُثير قلق النظام المصري تجاه إدارة بايدن هي ذاتها التي تُثير تفاؤل معارضيه، فإن هناك سوء تقدير جوهريا لدى هؤلاء المعارضين في تقييم الوزن النسبي لهذه العوامل ومدى قدرتها على دفع تغييرات حقيقية في الأوضاع السياسية في مصر.

يُعدِّد أستاذ العلوم السياسية المصري خليل العناني بعض أهم الأسباب التي تدفع إلى ترجيح هذا الاستنتاج، فمن غير المرجح أن يُخاطر بايدن بتقويض العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين بلاده والقاهرة من أجل قضايا حقوق الإنسان، حتى لو عنى ذلك بالنسبة له التعامل مع نظام استبدادي وغض الطرف عن بعض انتهاكاته، فضلا عن أن بايدن نفسه ينتمي لمعسكر أكثر محافظة داخل الحزب الديمقراطي، وكان من المتحفظين على الإطاحة بحسني مبارك إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بسبب خوفه من انزلاق مصر نحو الفوضى وعدم الاستقرار. وأخيرا، فمن المهم أن نتذكّر أن بايدن نفسه شغل منصب نائب الرئيس إبان حقبة القمع الدموي غير المسبوق أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013، وأن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن سياسيا في هذه الحقبة لم تَرْقَ أبدا إلى مستوى الحدث، ولم يكن لها تأثير يُذكر على المسار السياسي المصري.
إثر ما سبق، نجد أن سقف التوقعات المرتفع وغير الواقعي للمعارضة المصرية تجاه إدارة بايدن يستند بالأساس إلى تصورات مغلوطة وغير دقيقة حول الطريقة التي تُدار بها العلاقات الأميركية المصرية، وحول حجم النفوذ الذي تتمتع به أيادي واشنطن على النظام السياسي المصري وطريقة ممارسة هذا النفوذ ومجالاته، فضلا عن إرث الدروس السياسية التي تشرَّبها نظام السيسي من معاينته لتجربة العلاقات المصرية الأميركية تحت نظام مبارك، والفوارق الجوهرية في العقيدة السياسية لكلا النظامين (مبارك والسيسي) رغم تشابههما الظاهري في اعتناق سياسات القمع الشامل.
ففيما يتعلّق بطريقة إدارة العلاقات المصرية الأميركية، وعلى عكس ما قد يتبادر للأذهان للوهلة الأولى حول كون العلاقات بين البلدين تُعرَّف من خلال التفاهمات المباشرة بين القادة السياسيين؛ فإن الأجزاء الأهم مغزى والأكثر عمقا من الشراكة المصرية الأميركية تُدار من خلال البيروقراطيات في كلا البلدين، وبشكل أكثر تحديدا من قِبَل القادة الأمنيين في الجيوش وأجهزة الاستخبارات ووكالات الأمن القومي.
تتجلّى هذه الحقيقة أوضح ما يكون في الأوقات التي تكون فيها العلاقات السياسية متوترة أو مُلبَّدة بالغيوم كما حدث خلال الأشهر الأولى بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، حين بدت إدارة أوباما مُرتبكة وعاجزة عن صياغة سياسة متماسكة تجاه القاهرة، في حين كانت خطوط الاتصال مفتوحة على مدار الساعة بين السيسي ووزير الدفاع الأميركي آنذاك تشاك هيجل وكبار المسؤولين في البنتاغون، إلى درجة أن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأميركية قام بنشر نصوص 16 محادثة هاتفية بين السيسي وهاجل بين أغسطس/آب 2013 ويناير/كانون الثاني 2014.

تنسجم هذه الحقائق مع تأكيدات السيسي نفسه لصحيفة واشنطن بوست في أغسطس/آب 2013 أنه كان يُطْلع وزير الدفاع الأميركي على كل التطورات، يوما بيوم، طوال الفترة السابقة لتحرُّك الجيش ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، وهو مؤشر واضح على مدى تماسك العلاقة على المستوى الأمني والبيروقراطي على الرغم من الإشكالات التي شابتها على المستوى السياسي. وحتى على الصعيد الأمني فإن العلاقة المصرية الأميركية لا تتبع الصورة الكلاسيكية المختزلة في عقول العامة عن علاقة القائد بتابعيه، وبعبارة أوضح، فباستثناء الأمور المتعلقة بصرف المعونة العسكرية ومهام التنسيق الأمني والتدريب؛ فإن القادة الأميركيين لا يمتلكون نفوذا واسعا على نظرائهم في القاهرة، حتى فيما يتعلق بالتوجُّهات العسكرية والعقيدة القتالية للجيش المصري، فضلا عن أن يمتد هذا النفوذ إلى الطريقة التي يُسيّر بها الجيش شؤون السياسة الداخلية المصرية.
تتضح هذه الحقائق بجلاء في البرقيات التي سرّبها موقع ويكيلكس حول المداولات المستمرة بين القادة العسكريين المصريين والأميركيين خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك، التي أظهرت استياء الجنرالات الأميركيين من المُمانعة التي يواجهونها من نظرائهم في القاهرة بشأن تغيير عقيدة الجيش المصري للتجاوب مع التهديدات الأمنية الجديدة ذات الأولوية من وجهة نظرهم، مثل مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والقرصنة ومواجهة النشاط الإيراني، وهي أولويات أميركية لا يراها المصريون كذلك، وكذا استاء الجنرالات الأميركيون من تمسُّك نظرائهم المصريين، حتى ذلك الحين، بالدور المرسوم للجيش المصري بوصفه مؤسسة عسكرية تقليدية منوطة بحماية الأراضي المصرية ومواجهة الاعتداءات المحتملة من الجيوش النظامية الأخرى فقط.
على المستوى السياسي، فإن أحداث ثورة يناير كشفت مدى محدودية قدرة واشنطن على التنبؤ بمسار الأحداث المصرية والتحكُّم فيها مقارنة بما كانت تتصوره كلٌّ من واشنطن والقاهرة نفسها. وكما يشير الباحث الأميركي ستيفن كوك في كتابه "النضال من أجل مصر.. من ناصر إلى ميدان التحرير"، فإن جميع محاولات واشنطن لدفع نظام مبارك لإدخال إصلاحات ديمقراطية وسياسية ذات مغزى قد باءت بالفشل الذريع، رغم أن مبارك لطالما وُصِف بأنه أحد أكثر الزعماء قابلية للاستجابة للضغوط والرغبات الأميركية، ولم يحدث التغيير في مصر إلا حين تحرَّك المصريون نحوه بأنفسهم في ثورة يناير، وكان كل دور واشنطن ساعتها هو التصديق على هذا التغيير، ومحاولة ضمان أن التحوُّلات التي تجري في القاهرة لن تؤثر بشكل سلبي على مصالحها.
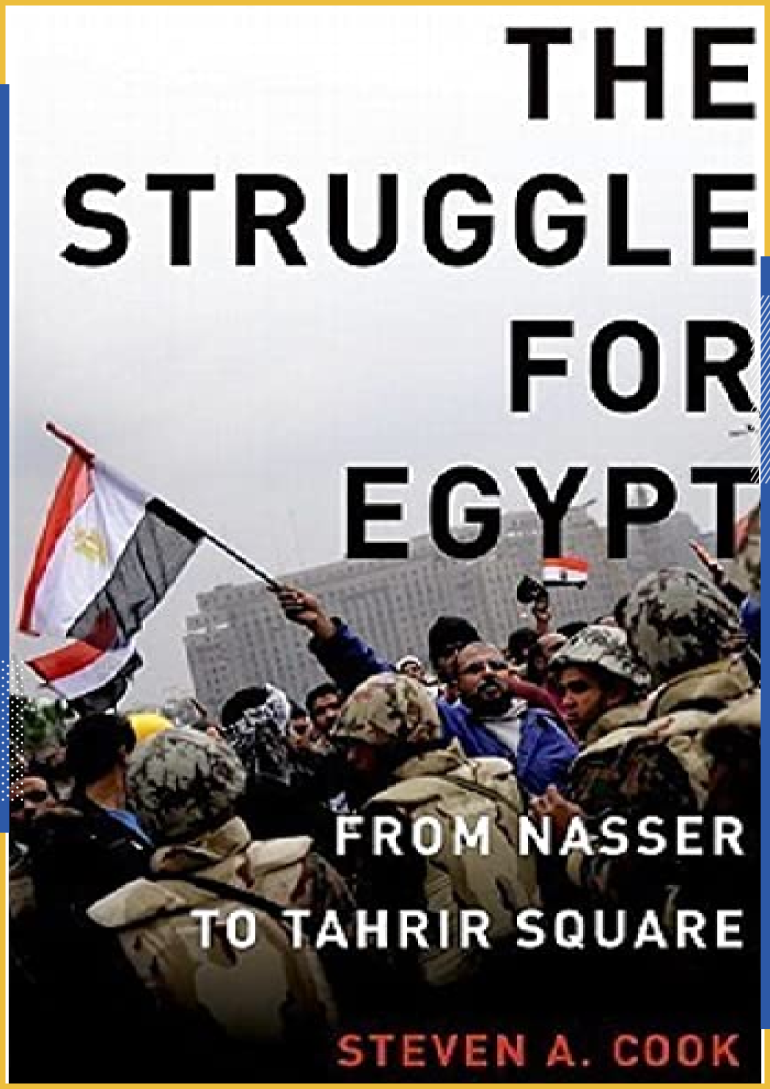
على النقيض تماما، يُشير كوك إلى أن النفوذ الأميركي في مصر كان دوما قوة مُثبِّطة للتغيير وليست دافعة له، خاصة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الاحتلال الإسرائيلي، وبوجه خاص خلال سنوات مبارك الأخيرة. فعلى مدار هذه الحقبة الطويلة، رأى المصريون أن سياسة بلادهم باتت مُسخَّرة لخدمة مصالح واشنطن وتل أبيب وضمان تدفُّق النفط بحُرية ومنع صعود أي قوة جديدة مُهيمنة في المنطقة، حتى لو تطلَّب ذلك إرسال 35 ألف جندي مصري للمشاركة في حرب الخليج عام 1990، وتقديم الدعم لغزو أميركا للعراق عام 2003، والتحالف الضمني مع إسرائيل خلال حرب لبنان عام 2006، وجميعها تصرُّفات أفضت إلى استعداء الرأي العام المصري، ودفعت مبارك نحو الاختيار بين موقفين لا سبيل له للتوفيق بينهما، فإما أن يكون رجل واشنطن، وإما أن يكون رجل الشعب، ويبدو أنه انحاز للاختيار الأول، وقرَّر ملء الفجوة الناجمة عن اختياره من خلال المزيد من القمع.
كان السبب الرئيسي لسقوط نظام مبارك إذن، للمفارقة، هو دعم واشنطن الواضح له، وليس تخلّيها عنه كما تُشير المقولات السائدة، وهي حقيقة يبدو أن نظام السيسي أدركها جيّدا في بدايات نشأته، فحرص على أن يصبغ صورته الشعبية بمظهر أكثر استقلالية عن واشنطن، وسمح بتكثيف الدعاية المناهضة للولايات المتحدة خصوصا في عهد أوباما، وفتح قنوات اتصال مبكرة مع خصوم واشنطن في روسيا والصين، ورغم توسُّعه في سياسات القمع -مقارنة حتى بعهد مبارك- فإنه تجنَّب التورُّط في صورة الرئيس الذي يمارس القمع نيابة عن الأميركيين، وللمفارقة، فإن هذه السياسة -الأكثر توازنا مقارنة بزمان مبارك- لم تتسبَّب في اختلالات كبيرة في القلب الصلب للعلاقات المصرية الأميركية، حيث استمر التنسيق الأمني والاستخباراتي والتعاون العسكري كما هو تماما -بلا تغيير- سواء في عهد أوباما أو بعد ذلك في زمان ترامب.


إذا كان لنا أن نختار أمرا أجَادَ فيه نظام السيسي، بخلاف إسكات خصومه بالقمع والترهيب، فسيكون هو قدرته على اللعب على أوتار مخاوف وتقلُّبات القوى الدولية برشاقة. ومن المتوقع أن تكون هذه المهارة هي ورقة السيسي الأهم في تعامله مع الضغوط المحتملة والتوترات المتوقعة في العلاقات المصرية الأميركية في عهد جو بايدن.
ففي الوقت الذي ستحافظ فيه القاهرة وواشنطن على وتيرة التنسيق التقليدية على مستوى الاستخبارات والدفاع، فإن مصر ستستثمر بجدية في تعزيز تحالفاتها السياسية، وكذا الأمنية والعسكرية، مع شركاء آخرين بخلاف الأميركيين، وقد قطع نظام السيسي بالفعل شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، فأقام علاقات قوية مع الصين وروسيا، ليس بشكل اقتصادي فقط ولكن أمنيا وعسكريا أيضا. فعلى سبيل المثال، اتخذت القاهرة قرارا حاسما عام 2018 بشراء طائرات حربية طراز "سوخوي (سو – 35)" من روسيا رغم اعتراض واشنطن، كما تُشغِّل مصر الطائرات بدون طيار الصينية من طراز "وينغ لونغ" في قواعدها العسكرية قرب الحدود الليبية.
عزَّز نظام السيسي أيضا من علاقته الأمنية مع العديد من القوى الأوروبية، وبعكس النظرة السائدة في زمان مبارك التي كانت تعتبر تلك العلاقات امتدادا طبيعيا للتعاون مع واشنطن، تكتسب علاقات السيسي مع القوى الأوروبية أبعادا أكثر استقلالية. ويظهر ذلك في علاقات مصر مع فرنسا على وجه الخصوص، حيث تُظهِر إدارة الرئيس الفرنسي ماكرون رغبة كبيرة في توريد الأسلحة وتعزيز التعاون الأمني مع القاهرة، دون ربط هذا التعاون بتحسُّن حالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة مع شهية القاهرة المتزايدة لتعزيز ترسانتها العسكرية التي حوَّلتها إلى ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم، ومنحتها مرونة في تنويع مصادر التسليح وتخفيف اعتمادها الحصري على المعونة الأميركية في هذا المجال.
في السياق ذاته، عزَّزت مصر أيضا من تعاونها الأمني مع عدد من الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم دول الخليج العربي والأردن وحتى العراق، وعلى الرغم من أن معظم هذه الدول حليفة للولايات المتحدة، فإن تعزيز التعاون بينها خارج المظلة الأميركية يُبيِّن رغبة واضحة في إظهار الاستقلال، خاصة أن القاهرة تُدرك أن لديها هامشا أكبر للمناورة السياسية في الوقت الراهن في ظل التحسُّن الملحوظ في أرقام الاقتصاد الكلي (يتوقع البنك الدولي أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي شهدت نموا في العام الماضي 2020 لأن البيانات الرسمية لم تصدر بعد) مقارنة بما كان عليه الحال قبل 4 أو 5 سنوات.
اللقاء الذي جمعني اليوم بأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وبأخي مصطفى الكاظمي خطوة مهمة في جهودنا لبناء التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك بين بلداننا، ولنؤسس نموذجاً للتصدي للأزمات من خلال التفكير الإيجابي والتشاركي في ظل جائحة "كورونا" pic.twitter.com/v3AJgkZOLN
— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 25, 2020
لكن ذلك لا يعني أن مصر لن تستثمر في تحسين صورتها في قلب أميركا إبّان عهد بايدن وترويج المقولات السائدة حول الدور الذي تلعبه القاهرة في الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط وحماية المصالح الأميركية، وقد وقّعت القاهرة بالفعل عقدا مع شركة ضغط أميركية بقيمة 65 ألف دولار شهريا من أجل تعزيز التواصل وتطوير العلاقات مع إدارة بايدن، ولن يكون مستبعدا أن تُدخِل القاهرة تحسينات شكلية في طريقة تعاملها مع بعض معارضيها السياسيين من أجل إرضاء الإدارة الأميركية ما دامت الضغوط التي تفرضها واشنطن في حدود المقبول. وعلى النقيض، ربما تدفع الضغوط الأميركية العلنية والمكثفة القاهرة لزيادة التنكيل بمعارضيها السياسيين حتى يُثَبِّت النظام سردية استقلاله وعدم تأثره بها.
وأخيرا، فمن المؤكد أن مصر ستسعى للاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل من أجل تخفيف الضغوط المتوقعة في واشنطن، وسيكون دور دولة الاحتلال واللوبيات التابعة لها حاسما، في مسألة المساعدات تحديدا، نظرا لارتباطها باتفاق السلام. فما دام التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل مستمرا، فإن تل أبيب ستبذل قصارى جهدها من أجل تجنُّب أي انقطاع في المساعدات الأميركية إلى مصر.
على الرغم من كل ذلك، ستظل هناك فوارق محسوسة في الطريقة التي سيتعامل بها بايدن مع النظام المصري مقارنة بزمان ترامب. وعلى الأرجح فإن إدارة بايدن ستوجِّه بعض الانتقادات اللاذعة لسجل القاهرة الحقوقي وحملتها ضد المعارضين والناشطين. نُرجِّح كذلك ألا تقف الإدارة الجديدة في طريق أي تشريعات يسعى الكونغرس لتمريرها حول حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، وقد تستجيب أيضا لضغوط تعليق بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لفترة من الزمن، وأخيرا، فمن المرجح أن بايدن لن يغامر باستضافة السيسي في البيت الأبيض أو زيارة القاهرة بنفسه على الأقل خلال النصف الأول من ولايته، لكن باستثناء هذه التغييرات، البروتوكولية والشكلية في مجملها، من غير المرجح أن تشهد العلاقات المصرية الأميركية أي تغييرات جوهرية خلال الفترة المقبلة، ولن تنجح الإدارة المقبلة في إحداث تغييرات حقيقية في الطريقة التي تُحكَم بها مصر، على الأقل خلال السنوات الأربع المقبلة.

