الجوائز الأدبية.. من يمنحها؟
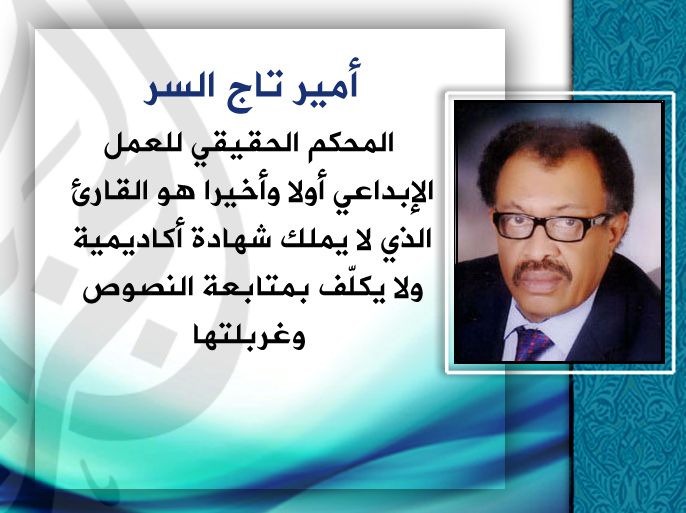
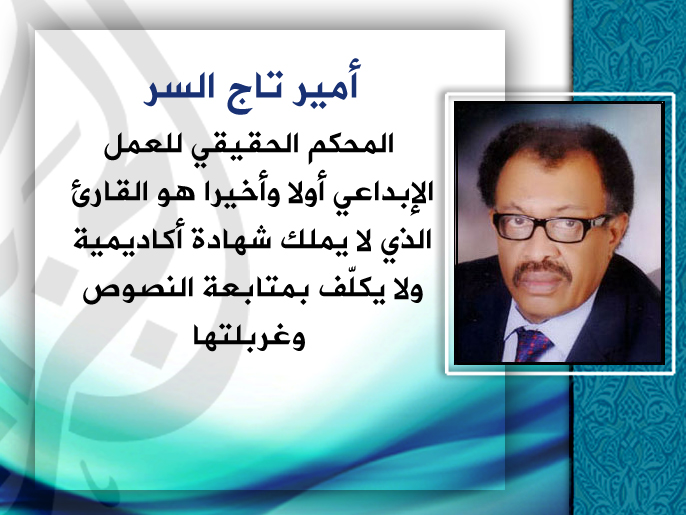
جوائز في الشعر وفي القصة وفي الرواية والمسرح، وحتى في الخواطر العادية التي يكتبها البعض، وترصد لها أحيانا جوائز في كثير من الصحف اليومية.
ولأن هذه الجوائز الأدبية ترف مستحدث في عالمنا العربي، بعكس الغرب الذي تعتبر لديه من التقاليد الراسخة وجزءا هاما من ثراء ثقافته، وهناك جوائز عمرها عشرات الأعوام، مثل جائزة غونكور الفرنسية ومان بوكر الإنجليزية، وجائزة بوليترز والأورانج النسائية، ونالها مئات المبدعين على مر الأعوام، فإننا، كما أعتقد، ما زلنا في صدد حضانتها المبكرة، قبل أن نصبح قادرين على التعامل معها بنضج ومسؤولية.
لكن، لمن تمنح تلك الجوائز حقيقة؟ وهل هي بالفعل تقدير للإبداع والمبدعين، كما تردد شعاراتها التي جاءت تحملها، أم مجرد ميادين، ترصف موسميا، ليتقاتل فيها المبدعون وغير المبدعين، وليس ثمة رابح حقيقي؟
| من خلال متابعتي لما ينشر، خاصة في مجال الرواية، أرى أن الأمر يعتمد أساسا على التذوق الذي يحمله المحكمون المفترضة نزاهتهم، أكثر من أي شيء آخر |
قبل ذلك كله، لا بد من إلقاء نظرة مطولة على التحكيم الذي لا بد منه من أجل أن يربح أحد ويخسر آخر. والتحكيم في تلك الجوائز، كما هو معروف، يتكون من لجان تضم أشخاصا لهم في الغالب علاقة بالكتابة، فإما أن يكونوا مبدعين، قدموا أعمالا من قبل، وإما نقادا أو أكاديميين، وأحيانا مجرد وجهاء مجتمعيين يحظون ببعض الاحترام ويمتلكون قدرا من الثقافة.
هؤلاء يكلفون بغربلة الأعمال المتقدمة للجائزة وتصفيتها واستخراج قوائم نهائية، يختار منها الفائزون بعد ذلك. هذا شيء مشروع، بلا شك، وحتى جوائز الغرب التي تأثرنا بها، واستوردنا بعضها، تتبع في معظمها نهجا مشابها لذلك، ما عدا جوائز تقرر بعض الأكاديميات منحها لمبدع ما، على مجمل أعماله، من دون أن يغربل نصوصه أحد.
لكن هنا يأتي السؤال المهم: ما هي المبررات التي تسوقها تلك اللجان المشكلة لمنح نص جائزة، وعدم منح نص آخر؟
من خلال متابعتي لما ينشر، خاصة في مجال الرواية، وأيضا من تتبعي لمسيرة تلك الجوائز سواء كانت عربية أو غربية، أرى أن الأمر يعتمد أساسا على التذوق الذي يحمله المحكمون المفترضة نزاهتهم، أكثر من أي شيء آخر. هناك من يتذوق النص الكلاسيكي الخالي من أي نكهة تجريب ويصوت له عن قناعة، ومن يتذوق نصا تجريبيا حداثيا أو كتب بلغة بعيدة عن المألوف ويصوت له، ومن لا يتذوق هذا ولا ذاك، أو يعترف بأي نص مهما كان. وليس الأمر خاصا ببلادنا في هذا الصدد، ولكن حتى بتلك الجوائز الغربية العريقة.
وأذكر تلك الناقدة الأميركية التي احتجت بشدة وهاجمت لجنة للتحكيم كانت عضوا فيها، لأن جائزة رفيعة المستوى منحت للروائي فيليب روث، لا لسبب إلا أنها لم تكن من عشاق أدبه، ولا اعترفت به كاتبا في أي يوم من الأيام، كما ذكرت في مقابلة معها. وحدث نفس الأمر في إحدى الجوائز العربية، لكن بطريقة مختلفة.
وفي العام الماضي، التقيت مصادفة بناقد أكاديمي من إحدى البلاد العربية، يمكن بسهولة شديدة أن يظهر اسمه ذات يوم بين محكمي إحدى الجوائز. تناقشنا في الكتابة طويلا عن أول رواية عربية كتبت، وأين ظهرت؟ وهل الرواية هي ديوان العرب الجديد بالفعل؟ وفوجئت به يخبرني بصرامة شديدة أنه يملك ست عشرة قاعدة أساسية في الكتابة يجب أن يستوفيها كل من يكتب رواية، حتى يطلق عليه لقب الروائي.
وقد قام بتطبيق تلك القواعد أولا على كتاب بلده بمختلف أجيالهم، ولم يحصل على روائي واحد. ونزح بها بعد ذلك إلى الخارج، وطبقها على عدد كبير من كتاب الوطن العربي المعروفين، ولم يحصل سوى على روائي واحد، انطبقت عليه القواعد كلها هو نجيب محفوظ،، أما الآخرون ممن حامت حولهم القواعد ولم تنطبق عليهم، فإما مشاريع روائيين لم تكتمل، وإما دخلاء على صنعة الرواية، كان أولى بهم أن يتركوها في حالها، ويتجهوا إلى مهن أخرى.
| هناك رأي آخر أكثر تطرفا، أن لا نعتبر من هو كاتب أو ناقد، أو لديه صلة بالكتابة، محكما محتملا في جائزة ما، إلا إذا خضع لتدريب خاص يزعزع ذائقته الثابتة، يفتحها على أفق أرحب |
إذا ما أخذنا تلك العسكرة النقدية لذلك الناقد الأكاديمي على محمل الجد، وسآخذها بكل تأكيد، يكون روائيون عظماء مثل الطيب صالح وجبرا إبراهيم جبرا، وحنا مينا وعبد الرحمن منيف وكثيرون غيرهم، مجرد مشاريع روائيين لم تكتمل لأسباب مجهولة. وجيلنا، والأجيال التي سبقته والتي أتت بعده، مجرد أدعياء ودخلاء على صنعة لا يعرفونها، وعليهم أن يبحثوا عن الذي يعرفونه.
والحقيقة، أنني لا أستبعد أبدا أن تكون تلك القواعد الست عشرة، أو قواعد شبيهة بها، مخبأة في أذهان آخرين، لكنهم لم يجرؤوا على التصريح بها كما صرح صاحبنا.
لذلك، أعود لتأكيد رأي طالما كنت من أنصاره، وهو أن المحكم الحقيقي للعمل الإبداعي، أولا وأخيرا، هو القارئ الذي لا يملك شهادة أكاديمية ولا يكلف بمتابعة النصوص وغربلتها، لكنه يكلف نفسه بنفسه، ولذلك طالما وجدنا أعمالا روائية كثيرة لفظت من الجوائز بفظاظة، لكنها حصلت على شرعيتها، وحققت انتشارها خارج القانون الأكاديمي، أو الرسمي.
وشخصيا اعتدت الرجوع إلى رأي القارئ واحتضانه في كثير من أعمالي، أراه يتسق مع التوجه الحقيقي للنص، أنه أنتج ليقرأ، خارج سلطة المنح والمنع التي تمنح أو لا تمنح الجوائز.
رأي آخر أكثر تطرفا، أن لا نعتبر من هو كاتب أو ناقد، أو لديه صلة بالكتابة، محكما محتملا في جائزة ما، إلا إذا خضع لتدريب خاص يزعزع ذائقته الثابتة ويفتحها على أفق أرحب.
وأخيرا، أقولها بكل صراحة، إنني أيضا بحاجة لذلك التدريب الشاق، حتى ألغي تذوقي الشخصي، الذي يتوقف جامدا عند أعمال معينة، ويرفض أعمالا أخرى مجيدة، لأنها خارج محيطه، لا لأكون محكما في مسابقة، ولكن نزيها في رأيي، حين أسأل عن أعمال جيدة المستوى، ولكني لم أحبها.
_____________
روائي وكاتب سوداني