تقرير تشيلكوت وأزمة المشروع الديمقراطي في أوروبا
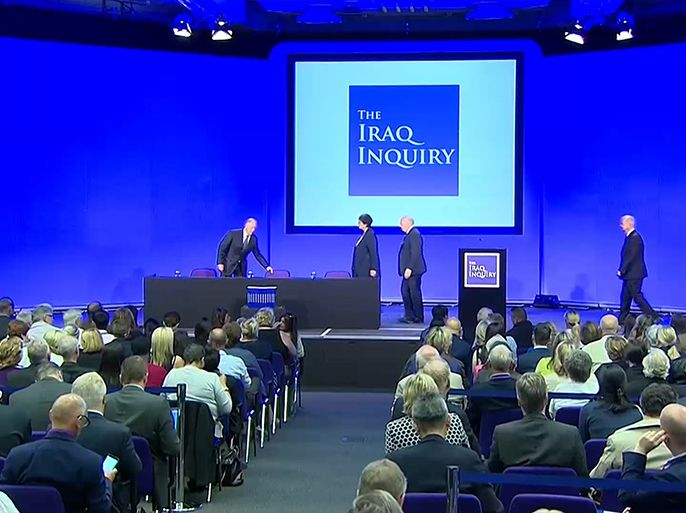
فرصة للأسئلة الجوهرية
انكشاف حدود الديمقراطية
بين السياسات البعيدة والقريبة
أزمة المشروع الديمقراطي
لن تخفت أصداء تقرير تشيلكوت سريعا، لكن من المستبعد أن يمتد الجدل إلى عمق الأزمة التي يلامسها التقرير على استحياء. فالمفارقة الجوهرية تتجلى في أن نتائج التحقيق تنتصب برهانا على أن الديمقراطية تعمل حقا، إلى درجة مساءلة صانع القرار الأول في البلاد سابقا وتوجيه انتقادات مباشرة له وإن بدرجة مخففة عن المتوقع، لكن ذلك يحدث بشكل متأخر للغاية أو بعد فوات الأوان.
فرصة للأسئلة الجوهرية
يأتي تقرير تشيلكوت البريطاني الذي يبحث في ملابسات شن حرب 2003 على العراق؛ ليكشف أخطاء جسيمة رافقت صناعة القرار الذي تسبب عمليا بإشعال حرائق واسعة النطاق وتفجير المنطقة، حتى خرجت النيران عن السيطرة اليوم وبات من الصعب تقدير مآلاتها.
أما فحوى التقرير الواقع في قرابة مليونين وستمائة ألف كلمة فلا يصح اختزالها بالخلاصة الشائعة بأن مسوغات شن الحرب لم تكن سليمة، أو أنها كانت مضللة حقا، فنتائج التحقيق مؤهلة فوق ذلك لإثارة أسئلة جوهرية قادرة على النفاذ إلى بنية المشروع الديمقراطي ذاته، ومحاكمة شفافية التطبيق، وهذا ليس في بريطانيا وحدها بل في أوروبا إجمالا.
جدير بالملاحظة أن التحقيق البريطاني المثير، الذي وقف على رأسه جون تشيلكوت وتم إرجاء الكشف عن نتائجه بدعاوى الحفاظ على أسرار تتعلق بالأمن القومي وعدم الإضرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة؛ يعزز استنتاجات من قبيل أن هامش التصرف الممنوح لصانعي السياسة الخارجية يتجاوز المنطق الديمقراطي بمراحل. فقد بلغ الأمر حد إقدام رئيس وزراء المملكة المتحدة على التعهد لسيد البيت الأبيض بالاصطفاف مع واشنطن في شن الحرب "مهما حصل"، وهذه العبارة الأخيرة إنما تعني ببساطة، أن القرار سيمضي مهما واجه من اعتراضات في أعرق ديمقراطيات العالم.
نجح توني بلير بالفعل في تجاوز كل الاعتراضات على قرار الحرب، وضرب بإرادة الجماهير البريطانية عرض الحائط، والأهم أن أوساطا من النخبة السياسية بما في ذلك البرلمان، تواطأت مع القرار التاريخي أو تجاهلت الاعتراضات الشديدة عليه وتغاضت عن التحذيرات المكثفة من عواقبه. جرى ذلك رغم أن بريطانيا لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا موجة تنديد شعبية بقرار ما كما عرفته قبيل شن الحرب على العراق.
فعلى مدى شهور متواصلة بدءا من خريف 2002 انتظمت في المجتمع المدني والأوساط المثقفة تحركات مناوئة لقرار الحرب، نجحت بصفة متكررة في حشد أعداد قياسية من الجماهير في لندن وأنحاء البلاد، لكن ذلك كله لم يشفع لدى حكومة بلير التي بدت مصممة على الغوص في رمال العراق بموجب ترتيبات تحالفية مسبقة مع إدارة بوش الابن على الجانب الآخر من الأطلسي، مع شرعنة الخطوة في مجلس العموم الذي بدا موقفه بعد صدور تقرير تشيلكوت باعثا على الشفقة.
انكشاف حدود الديمقراطية
برهن التوجه البريطاني إلى غزو العراق آنذاك أن للديمقراطية حدودا في التطبيق، وأن إستراتيجيات السياسة الخارجية وقراراتها الكبرى يجري رسمها غالبا بمعزل عن أي نقاش شعبي حقيقي، وقد يتم في بعض الحالات الاكتفاء بمحاولة شرعنتها حسب الحد الأدنى من الأنظمة والأعراف المعمول بها، ثم يجري تسويقها للجماهير بطريقة إقناعية محترفة إلى درجة الولوغ أحيانا في التضليل.
ما انفكت السياسات الخارجية للدول الديمقراطية مرتهنة بالتالي لمنطق راسمي الإستراتيجيات وخبراء إدارة الصراعات والحفاظ على المصالح والأمن القومي الذي يمتد عبر "المجال الحيوي" الذي قد يبلغ رقعة العالم بأسره، علاوة على منظور خاص نحو الأدوار والتوازنات في المجتمع الدولي، ولا متسع هنا للقيم والمبادئ والشعارات الجميلة إلا إن توافقت مع هذا كله.
وفوق ذلك؛ فإن الكلمة في توجيه السياسات الخارجية ليست للشعب حتما، بل لنخب التفكير الإستراتيجي وفرق الحكومة ووزارة الخارجية، والعسكر وتحالفاتهم الأطلسية، والأجهزة التي تعمل في الظل تحت لافتة الاستخبارات مستفيدة من صلاحيات تصرف واسعة للغاية عبر العالم.
من القسط القول إن الإخفاق الذي ينضح به تقرير تشيلكوت لا يمس الديمقراطية في نطاقها البرلماني وحسب، وهو نطاق تم تضليله لاتخاذ قرار الحرب، حسب انتقادات زعيم حزب العمال جيرمي كوربن بعيد صدور التقرير، بل يمتد إلى خلل في بعض آليات المجتمع الديمقراطي الأخرى، مثل الصحافة التي لم تنهض بواجبها في لحظة الحقيقة، وحصون الفكر التي سمحت بتمرير قرار بالغ السوء دون أن تقرع نواقيس الخطر؛ فالمأزق الذي يشي به التقرير هو كيف تم السماح لتجاوزات فادحة في نظام يسود الظن بأنه ديمقراطي ومحكوم بالقانون والمؤسسات ويراقبه مجتمع مدني يقظ؟
بين السياسات البعيدة والقريبة
تبقى التجاوزات التي أقدمت عليها حكومة بلير بمعية آليات صناعة القرار وشرعنته، منسجمة على أي حال مع معضلة مزمنة تتعلق بموقع السياسة الخارجية من النظام الديمقراطي ككل.
فالديمقراطيات الغربية لا تلتزم في النطاق الخارجي للدولة بالثقافة الديمقراطية السائدة في نطاقها الداخلي، بمعنى أن التصرف في فضاءات السياسة الدولية "البعيدة" يجري بشكل أقل شفافية ويخضع لمنطق آخر مغاير لنظيره في السياسات الداخلية "القريبة" التي يواكبها الشعب جيدا. ومن أوضح ما يجسد هذه الحقيقة هو مجلس الأمن، وتحديدا من خلال الامتيازات الخاصة غير الديمقراطية الممنوحة للدول دائمة العضوية، ومعظمها ديمقراطيات في الأساس لكنها تحظى بحقوق استثنائية متعالية على غيرها من الأمم.
وإن خضعت السياسات الداخلية لنقاشات واسعة عادة، وتصدرت البرامج الانتخابية؛ فإن صناعة القرار في السياسات الخارجية تتم بمنطق الإستراتيجيات والمصالح والأمن القومي، لا المشاركة الشعبية أو المفاوضة المجتمعية، وهذا منطق لا يطابق الشعارات الزاهية التي يتم تغليف السياسات بها. وما يشجع ذلك هي لامبالاة الناخبين والناخبات، وضعف اكتراث الجمهور بالأداء الخارجي، وضحالة منسوب الوعي بما يجري وراء البحار، والاكتفاء بالرواية الرسمية أو شبه الخارجية للأحداث الخارجية والسياسات والمواقف ذات الصلة.
يعني ذلك في الواقع أن الافتراق قائم لا محالة بين منطق السياسات الداخلية والخارجية، علاوة على الفجوة بين الشعار والتطبيق في نطاق السياسات الخارجية ذاتها. فقد ظل دعم الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان من ثوابت الخطاب السياسي الخارجي للدول الأوروبية، ومنها بريطانيا؛ بينما تجنح الممارسة الفعلية بعيدا عن هذه الشعارات الزاهية، تماما كما وصف بلير ما جرى في العراق بالإنجاز حتى بعد صدور التقرير.
لقد اتضحت هذه الفجوة في محطات شتى، ومنها موسم الحرية والديمقراطية العربي القصير، الذي خذلته أوروبا أو تراخت إزاء سحقه بعد أن صفقت لذلك "الربيع". كما أن سياسات الانحياز التقليدية لنظام الاحتلال في فلسطين، على سبيل المثال، لم تخضع منذ منشئها لأي نقاش شعبي يُذكر، وينسحب ذلك على ملفات السياسة الخارجية إجمالا. بل إن تقرير تشيلكوت انصب على الأضرار التي ألحقها قرار الغزو ببريطانيا ومصالحها أساسا، وهي لا تُقارن بحال بما جره القرار على منطقة واسعة دفعت ثمنا مذهلا للحرب.
أزمة المشروع الديمقراطي
قد ينكشف المأزق في ملفات السياسة الخارجية عندما يتضح لقطاعات من الشعب أنها متضررة مباشرة من بعض تلك السياسات، فيصعد الاهتمام بها وتدخل في أتون الجدل الداخلي، وهو ما قد يجري في بريطانيا مثلا بضغط من أسر الجنود الذين قضوا في العراق انصياعا لقرار الحرب الذي لم يخضع لآليات ديمقراطية شفافة.
وإذ يلامس تقرير تشيلكوت جانبا بالغ الأهمية من أزمة المشروع الديمقراطي في التطبيق الأوروبي؛ فإنه يأتي بعد أيام من اتضاح وجه آخر لهذه الأزمة، عندما صوتت أغلبية البريطانيين في سويعات وعلى نحو مغرق بالعاطفية، للفكاك من مشروع عملاق استغرق تشييده ثلثي قرن من الخطوات الدؤوبة. وقد اتضح بالتالي أن الديمقراطية المباشرة التي يتم خوضها عبر الاستفتاءات الشعبية في المقام الأول، تتصدر اليوم المخاطر المحدقة بمشروع الوحدة الأوروبية، حتى أن ما يشغل صانعي القرار الأوروبي حاليا هو كيفية إبعاد شبح صناديق الاقتراع عن حلم الوحدة كي لا ينفرط عقد الاتحاد.
وإن كان لتقرير تشيلكوت من أهمية جوهرية؛ فتبقى مرتهنة لاستثماره في خوض مساءلات جادة، وهو بدونها يظل تأريخا شيقا لملابسات إحراق العراق والمنطقة. والمؤكد أن المعضلة لا يمكن حصرها في بلير الذي خرج من الخدمة، بل ببنية المشروع الديمقراطي التي أتاحت له أن يذهب بعيدا، علاوة على ضلوع التقارير الاستخبارية المضللة في الدفع بقرار كهذا وما يشير إليه ذلك من مكامن خلل في عملها.
أما إن غابت المراجعات العميقة بعد هذا التقرير العريض؛ فقد يؤول المشهد إلى كلمات جوفاء من قبيل تلك الكلمة (آسف) التي نطق بها بلير بفتور بعد سنوات متواصلة من تأجيج الحرائق.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
