أتحتاج الثقافة إلى عاصمة؟
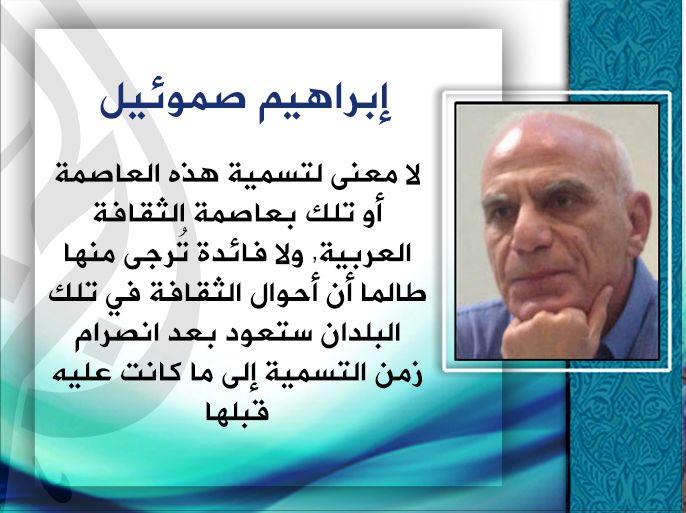
إبراهيم صموئيل*
من دون أن يطلق على باريس أو لندن أو روما لقب عاصمة للثقافة الأوروبية، ومن دون أن يتم تخصيص عام محدد لأي من تلك العواصم كي تمثل هذا الدور، سعت كل عاصمة منها -على حدة وبالتعاون مع غيرها- لأن تنهض بالحياة الثقافية وتعمل على ازدهارها في مختلف الفعاليات والأجناس والألوان الثقافية والأدبية والفنية.
الأمر نفسه يسري على العديد من المدن والعواصم التي سعت لتطوير نفسها، وقد تجلى في كافة الحقول والأصعدة الثقافية وغير الثقافية، لا بسبب من تسمية، ولا تلبية لمناسبة، بل ترجمة عملية لخطط شاملة تهدف إلى النهوض والارتقاء والحضور عاما بعد عام، ودرجة بعد درجة إلى أن تصبح تلك العاصمة قِبلة للتطور والازدهار، وهو ما بات معروفا عند الحديث عن تجربة النهضة اليابانية من تحت الصفر في الحرب العالمية الثانية إلى مكانتها الكبرى تحت الشمس اليوم.
بالطبع, ما من أضرار تنتج عن تسمية هذه العاصمة العربية أو تلك "عاصمة للثقافة العربية" على مدار سنة من الزمن. غير أنه يُفترض بتقليد ثقافي كهذا أن يأتي لتحفيز الإنتاج الأدبي والفكري والفني، ولحث الوزارات والهيئات والمؤسسات الثقافية على الالتفات أكثر والاهتمام بجدية أكبر لوضع خطط نهوض شاملة بغية الدفع بالحياة الثقافية للازدهار والارتقاء بها إلى مراتب عليا.
ثقافة المواسم
ويُفترض بتقليد كهذا أن يكون اللبنة الأولى في العمل على إجراء قطيعة مع ماضي بلد العاصمة المسماة، سواء كان إهمالا للثقافة، أو تضييقا على نتاجاتها، أو تهميشا لمبدعيها، أو تقصيرا في منح التراث الثقافي ما يستحق من مكانة، وما إلى ذلك مما يجري عادة لدى مختلف الشعوب والبلدان الطامحة للتطور.
| ستأفل شمس المناسبة نهاية العام المخصص لها ليعود المبدعون إلى ما كانوا عليه من مكافحة ومنافحة لنيل الموافقة على طباعة مخطوط، أو للعمل على إزالة أسباب هجرة العقول والكفاءات، أو لمواجهة فتاوى التحريم وهدر دماء المبدعين |
السائد والحاصل غير ذلك تماما، إذ ينظر المسؤولون والمعنيون في العاصمة المُختارة إلى التسمية كمناسبة لا بأس من استثمارها إعلاميا وسياسيا لصالحهم -على غرار استثمار مهرجان للسينما أو المسرح- فيُصار إلى تنشيط المطابع بغية إصدار العديد من الكتب الأدبية والفنية والفكرية، وتفعيل الأمسيات والندوات والملتقيات, وتمديد رقعة النشاطات نحو القرى والأرياف، والقيام بزيارات إلى المتاحف والمكتبات الوطنية ومواقع الآثار، وإجراء المقابلات والحوارات، وإطلاق أيدي الإعلاميين لتغطية كل المجريات والوقائع والفعاليات بحيث يبدو البلد ثقافيا كشمس ساطعة في عز الظهيرة.
مع الأسف, ستأفل شمس المناسبة نهاية العام المخصص لها ليعود المبدعون إلى ما كانوا عليه من مكافحة ومنافحة لنيل الموافقة على طباعة مخطوط، أو للسماح بتبادل المطبوعات بين بلدهم والبلدان العربية، أو للعمل على إزالة أسباب هجرة العقول والكفاءات، أو لمواجهة فتاوى التحريم وهدر دماء المبدعين، أو لوضع قوانين تحفظ حقوق التأليف والنشر، أو للدفع من أجل إحياء التراث الثقافي التنويري ونشره… إلخ.
في ظل واقع جار كهذا، لا معنى لتسمية هذه العاصمة أو تلك بعاصمة الثقافة العربية, ولا فائدة تُرجى منها طالما أن أحوال الثقافة في تلك البلدان ستعود بعد انصرام زمن التسمية إلى ما كانت عليه قبلها, وطالما أن هذا الحض على الاهتمام والرعاية والتطوير لا يثمر, اللهم إلا إن أردنا إعلام المبدعين والمهتمين بالثقافة أن بإمكان المسؤولين القيام بذلك، لكنهم لا يريدون.
غياب الروح
الحال المشابه سنلاحظه في المهرجانات الدورية للسينما والمسرح التي تُقام في هذا البلد العربي أو ذاك, إذ يُفترض بالندوات واللقاءات التي تُعقد والتوصيات الصادرة عنها, والتي تشدد على أهمية الفن المسرحي وكذا الفن السابع ودورهما الثقافي ومكانتهما في العالم, وعلى الضرورة الماسة لرعاية هذين الإبداعين وتطوير عروضهما نوعا وكما وانتشارا أن تنهض بالحياة السينمائية والمسرحية وترتفع بها, غير أن واقع هذين الفنين في الدول العربية من تدهور إلى تدهور, حتى وصل الأمر ببعض المهرجانات أن خلت تماما من أي فيلم عربي مشارك, كما صرح الفنان حسين فهمي بذلك حين ترأس أحد المهرجانات يوما.
|
إذا ما حذفنا احتشاد الوفود المدعوة, وبهرجة الخطابات، والأمسيات المتزاحمة، والفورة المؤقتة للمطبوعات، فإن تسمية هذه العاصمة أو تلك لم تُترجم إلى قرارات وقوانين تفتح صفحة جديدة على الحياة الثقافية |
وبهذا المعنى، إذا ما حذفنا احتشاد الوفود المدعوة, وبهرجة الخطابات، والأمسيات المتزاحمة، والفورة المؤقتة للمطبوعات، فإن تسمية هذه العاصمة أو تلك لم تُترجم إلى قرارات وقوانين تفتح صفحة جديدة على الحياة الثقافية، وتمدها بأسباب النهوض، وتعيد للمبدعين والمثقفين العرب حقوقهم التي حُرموا منها، ومكانتهم التي يستحقونها، وتدفع بالبلد للتقدم عبر احترام أرقى ما تنتجه البشرية: الثقافة.
وفي النهاية، تؤكد التجربة أن البلدان العربية التي كانت تهتم -نسبيا- بالحياة الثقافية ظلت على اهتمامها, والبلدان العربية التي كانت تعادي الثقافة والتنوير، وتحاصر المبدعين فيها، وتدفع بالعقول دفعا للهجرة، وتمارس الطغيان بحق المثقفين قبل التسمية, ظلت على ما هي عليه بعد زمن التسمية.
فعلامَ, إذن, كل تلك المظاهر والضجيج والتكاليف إن لم تُنتج طحينا يغذي وينفع؟ أم إن كل ذلك لا يعدو ما عبر عنه رسم كاريكاتيري بإظهار أمٍّ تكد وتشقى بعمل المنزل ورعاية زوجها وأبنائها إلى أن يحل يوم عيد الأم, فيطلب منها الجميع التربع على عرش الراحة والتكريم والدلال, حتى إذا ما انقضى يوم الحادي والعشرين من آذار عادت المسكينة إلى ما كانت عليه من الشقاء والكد.
_______________
* كاتب وقاص سوري