من ضرورات الكتابة

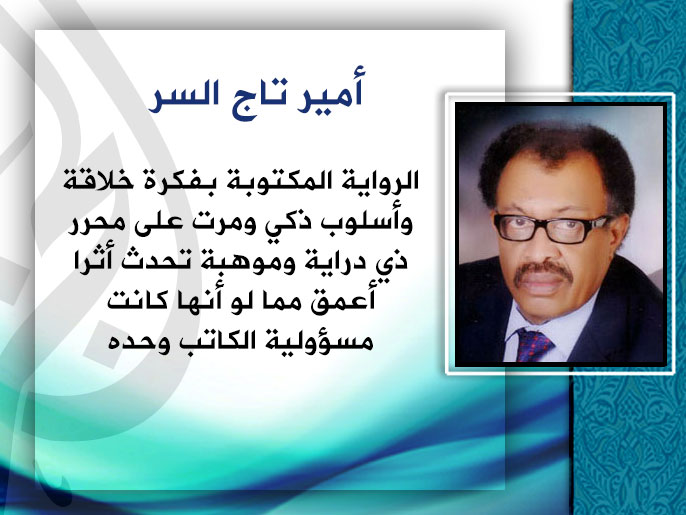
قالت الكاتبة إنها حين أنهت روايتها واعتبرتها صالحة للنشر كتبت أن الراوية ذهبت إلى عرس فقط من دون تفاصيل، لكن المحررة -التي تشرف على تحرير مسوداتها في دار النشر- أعادت إليها المسودة، طالبة منها أن تكتب تفاصيل العرس كلها، لأن قارئا لا تعرفه قطعا يتلهف لمعرفة ماذا جرى في ذلك العرس، وقد يصاب بإحباط كبير إذا ما قرأ المشهد ولم يعثر على التفاصيل التي يريدها.
وبناء على رأي المحررة أعادت الكاتبة تلك الجزئية، وكانت من الجزئيات التي نجحت بالفعل، ودائما ما تذكر في كل قراءة تتحدث عن الكتاب.
| لو نظرنا إلى تلك الروايات العظيمة التي تأتينا مترجمة من الغرب ونستمتع بأجوائها لما تخيلنا أن الكثير من أجوائها كانت بإيحاءات من محررين محترفين عملوا عليها من دون أن يخفض ذلك من قدر الكتاب الذين صاغوها |
وفي زيارة لي إلى إيطاليا منذ عدة أشهر التقيت كاتبا إيطاليا واسع الانتشار إلى حد ما، أخبرني أن كثيرا من المشاهد الدرامية الناجحة في أعماله جاءت كتابتها بإيعاز من محرره الذي يعرف كثيرا من الأسرار، ويوحي إليه بأفكار ناجحة، ومنها مشاهد لم تكن تخطر بباله أثناء الكتابة، وحين كتبها في النسخ المعدلة قبل النشر بات مستغربا كيف أنه أغفلها حقيقة.
إذن كانت الصديقة الكاتبة والكاتب الإيطالي لا يتحدثان عن وظيفة مترفة، أو وظيفة بلا ضرورة وهي وظيفة المحرر الأدبي، ولكنهما تحدثا عن واحدة من أهم الوظائف في صناعة النص الأدبي وانتشاره، فالأمر هنا ليس حكرا على الكاتب فقط، ولكن هناك من يشاركه ترتيب النص وتجميله، وتحسين مستواه حتى يخرج للقراء في أفضل حالاته.
صحيح أن الكاتب هو من يعثر على الفكرة، من يسعى لتطويرها ومن يبذل جهدا مضاعفا لكتابتها، لكن حتما تظل النظرة الأخرى -خاصة إن كانت نظرة ثاقبة ومحترفة- مطلوبة بشدة لتمنح النص رونقه الأخير كما ذكرت.
ولأن الكتابة في الغرب مهنة عريقة تشبه الطب والهندسة والقضاء وغيرها من المهن، ويقوم بها موظفون هم الكتاب أو المبدعون عموما، فقد أوجدت من حولها تلك المهن الأخرى المهمة، كالتحرير الأدبي والطباعة والنشر، والتوزيع وغيرها.
يتضح لنا إذن أن المحرر الأدبي يستطيع أن يشارك ولو بحرف واحد يمنح النص تميزا، وأيضا يمكنه ألا يقترح أي تعديل للنص بعد قراءة المسودة، ويكون هذا أيضا رأيا جيدا، يأخذ به الكاتب والناشر معا.
ولو نظرنا إلى تلك الروايات العظيمة التي تأتينا مترجمة من الغرب ونستمتع بأجوائها لما تخيلنا أن الكثير من أجوائها كانت بإيحاءات من محررين محترفين عملوا عليها، من دون أن يخفض ذلك من قدر الكتاب الذين صاغوها.
لكن هناك سؤال تبادر لذهني وسألته للكاتبة الزميلة وأيضا للكاتب الأوروبي وبعض الذين تعاونوا معي في الترجمة: ما هي المؤهلات المطلوبة لدى الشخص حتى يشغل وظيفة المحرر الأدبي ويضيف كل تلك البهارات على نصوص الكتاب؟
الإجابة: لا مؤهلات كبرى حقيقة، ومثلما أن الكاتب نفسه غير مطالب بأن يكون من حملة المؤهلات الكبرى حتى يكتب قصة أو رواية، فالمحرر أيضا كذلك. هي موهبة يحملها البعض ولا يحملها البعض الآخر، وهي ذكاء وقدرة جينية للنظر عميقا في النصوص والإضافة إليها أو الحذف منها.
بعض أولئك المحررين قد يكونون هم أنفسهم كتابا للروايات أو شعراء لم تنجح نصوصهم، أو قد يكونون يعرفون أدق خصائص الكتابة، لكنهم اكتفوا بالتحرير من دون أن يكتبوا حرفا واحدا.
والشيء المدهش في وظيفة مثل أولئك المحررين أنهم ينحازون لما يرونه مناسبا بلا تذوق شخصي، بعكس الكاتب حين يعمل محررا، هنا سيفتقد الحياد المطلوب وسيتعامل مع النصوص بحسب طريقته في الكتابة، وليس معيار الجودة أو إضافة ما يميز تلك النصوص.
| إننا بحاجة لوظيفة المحرر الأدبي الرسمية في العالم العربي، وحين تكون رسمية، قطعا هي ملزمة بخلاف رأي الصديق أو الزوجة، وهو رأي ربما يلتزم به الكاتب وربما يلقي به بعيدا |
أعتقد أننا وعلى الرغم من عدم وجود وظيفة المحرر الأدبي في العالم العربي- أي في ثياب وظيفة رسمية ملحقة بدور النشر- إلا أننا نملك هذه الوظيفة بالفعل بطريقة أخرى، فكثيرا ما نقرأ في حوار مع كاتب أنه يعطي النص إلى أحد أصدقائه ليعطي رأيه فيه قبل أن يرسله إلى الناشر، وهنا لا بد أن رأي الصديق هذا قد أضاف شيئا أو حذف شيئا أخر. أيضا، هناك من يردد أن زوجته هي قارئته الأولى، وهنا نستطيع كذلك أن نستشف ما يمكن للزوجة أن تفعله بنص أراد صاحبه رأيها فيه.
أذكر عام 1987 حين كتبت روايتي الأولى وكانت بعنوان "كرمكول" -على اسم قرية ريفية ولدت فيها- أن ذهبت بها إلى مثقف مصري يقيم في طنطا قريبا من مكان إقامتي، كان اسمه "محمد الشيمي"، وكان معروفا بعشقه للكتب ومصادقتها وحفظ مقاطع عديدة منها يرويها للناس في الطرق والمقاهي.
كان الشيمي أول من لفت انتباهي إلى روائع لم أكن قرأتها آنذاك، مثل "يوليسيس" لجيمس جويس، و"جابريلا قرفة وقرنفل" لجورجي أمادو، و"مديح الخالة" لماريو فارغاس يوسا، سجنت الشيمي عدة ساعات وأنا أقرأ عليه نصي كاملا، وحين فرغت وجدته ينحاز للنص بشدة، ثم يزودني بعدة أفكار أخرى ستساهم -إن طبقتها- في زيادة إبهار النص.
الذي حدث أنني لم أفعل ما أشار به الشيمي ونشرت النص بهيئته نفسها التي كتبته بها، ولو فعلت لربما كان لتلك الرواية القصيرة -التي انمحت الآن من قائمة كتبي- شأنا آخر، لقد كان الشيمي محررا بثقافته ومقدرته وكنت مبتدئا بحاجة لوظيفته وعلى الرغم من ذلك لم أستغلها.
أخلص إلى أننا بحاجة لوظيفة المحرر الأدبي الرسمية في العالم العربي، وحين تكون رسمية، قطعا هي ملزمة بخلاف رأي الصديق أو الزوجة، وهو رأي ربما يلتزم به الكاتب وربما يلقي به بعيدا.
قطعا ستضيف مثل تلك الوظيفة كثيرا للإبداع المكتوب، وسنتخلص من الزوائد التي تملأ الروايات بلا معنى. الرواية المكتوبة بفكرة خلاقة وأسلوب ذكي ومرت على محرر ذي دراية وموهبة، تحدث في رأيي أثرا أعمق مما لو أنها كانت مسؤولية الكاتب وحده.