طوفان الرواية وضحاياه
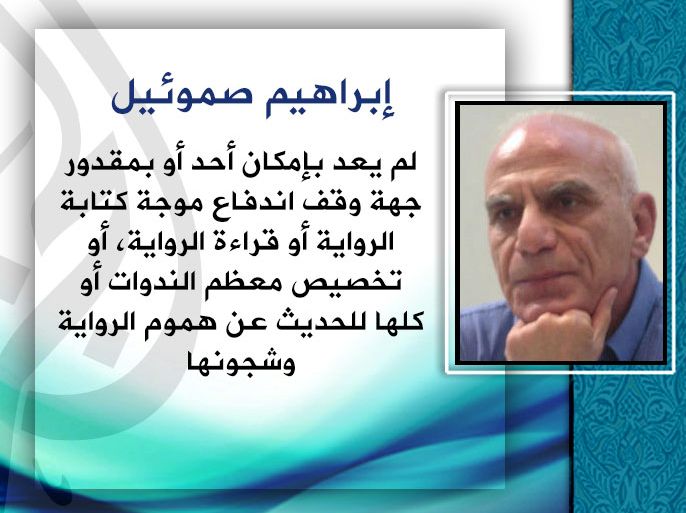
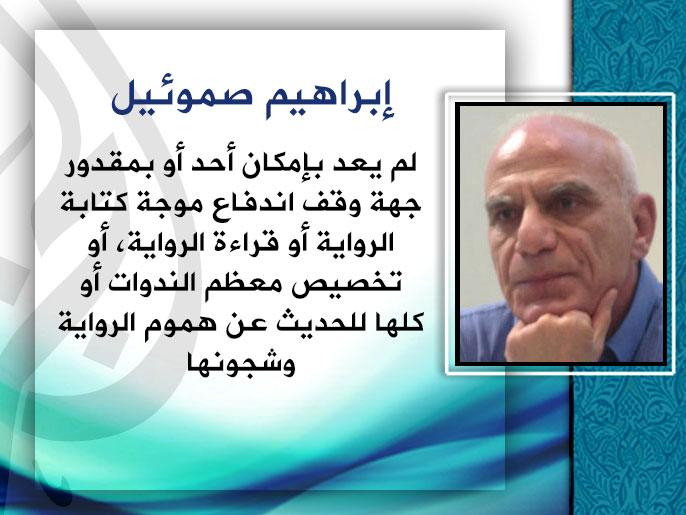
الاستجابة الثقافية العربية لمضمون الفرمان تنامت سريعا: فمن كان يشتغل على مجموعة من القصص، تناول أطول واحدة لديه، فمدها ومطها، متزايدا في أحداثها، وملصقا بعض الشخصيات بها، ومُجريا حفنة من حوارات وسجالات إلى أن غدت، بالحجم، رواية!
والذي تفتّحت روحه عن قصائد شعرية، كان يغزلها بأناة، ركنها جانبا -وقد بدا لنفسه كالمراهق في الأدب- وانكبّ على كتب التاريخ العربي، يستعين بأحداثه الجلل وبشخصياته المعروفة، ليتمكن من إنجاز ملحمة روائية!
وهال كاتب المسرح استمراره في الاشتغال على فن آفل، فأنشأ سردا لحوار شخصياته، وأضاف تداعيات ذهنية ورؤى وخيالات، موسعا ومنوّعا من الأمكنة حتى صار يحق له الانتساب بجدارة إلى الجنس الأدبي الرائج وديوان العرب الجديد: الرواية!
من جهتهم، لاحظ النقاد والدارسون والصحافيون تدفق الكتاب وتزاحمهم بغية صعود مركب الرواية، فعادوا إلى تاريخ الأدب للبحث والتفتيش عمن تراه يمكن أن يكون "آدمَ العربي" للرواية، وراحوا يجتهدون لتقرير نشأته الأولى، والتعرف إلى أفخاذه وفروعه وأبنائه وصولا إلى أحفاده في يومنا الراهن.
أصحاب دور النشر، وقد انتبهوا بدورهم إلى الموجة الكاسحة، نزعوا عن رفوف مكتباتهم البطاقة التقليدية المغبرة: "الدين ممنوع والعتب مرفوع" وخطوا مطرحها بطاقة جديدة: "نشر الرواية مرغوب، وما عداها محجوب"!
| الإبداع يبقى هو الإبداع، والقيمة تبقى هي القيمة، بصرف النظر عن الجنس الأدبي أو اللون الفني |
أصحاب المكتبات الذين تباهوا بمجموعة قصصية من هنا، وديوان شعر من هناك، ونص مسرحي من هنالك، جمعوا ما كانوا يتباهون بعرضه على واجهاتهم الزجاجية وراحوا يوزعون مطارحها ما صدر من روايات، تأليفاً وترجمة، ولو من أقاصي الأرض!
وفي هيجان ما شاع وكُرّس على مساحة المشهد الثقافي العربي، صار مستحيلا أن يخلو لقاء من حديث عن الرواية، أو تنجو ندوة من أبحاث في تاريخ الرواية، أو يقام مهرجان إلا للنظر في أحوال الرواية، أو تدعو مؤسسة إلا للوقوف على تطور الرواية!
القراء، وقد رأوا أن الأمر جدي، من أعلى الهيئات وأكبر الكتاب إلى أدناها وأحدثهم, تركوا ما بين أيديهم، واندفعوا يبحثون عن الرواية، أو أي كتاب يحمل على غلافه البراق كلمة: رواية!
وهكذا, لم يعد بإمكان أحد، أو بمقدور جهة وقف اندفاع موجة كتابة الرواية، أو قراءة الرواية، أو تخصيص معظم الندوات أو كلها للحديث عن هموم الرواية وشجون الرواية وشؤون الرواية.
لنفترض أن أسباب ودوافع تصدّر الرواية للمشهد الثقافي العربي قد تولّدت من تصدرها وشيوعها في بلدان أوروبا والأميركيتين وصولاً إلى اليابان وأستراليا (عملا بمبدأ التحاق الضعيف بالقوي)، فهل يعني ذلك أن تجبّ الرواية ما عداها، وتُمحق أجناس أدبية أخرى، من قِبَلِ معظم النقّاد والهيئات الثقافية والمهرجانات؟
وإذا كان الأمر يكمن في أن العالم بات قرية صغيرة، وأن مقاومة العولمة في حقل الأدب غير ممكنة، ولا بد من الانصياع لمتغيرات العصر.. فلماذا كلما تصادف أن كُتب أو جرى الحديث عن قصص عربية كان لازما لزوما شبه مطلق ذكر اسم "أنطوان تشيخوف" وتوصيف قصصه بـ"الخالدة"؟
ولماذا إذا ما ذُكر اسم "إدغار آلان بو" تُرفع الأيادي إقرارا وتطأطئ الرؤوس احتراما لفن القصة القصيرة، رغم رحيلهما قبل ما يزيد على قرن من الزمان، ورغم أن عصرنا الحالي هو للرواية؟!
| لا علاقة بين تحقق القيمة الإبداعية لأي جنس أدبي أو لون فني، وبين "الموضة" الدارجة في هذا العصر أو ذاك، إذ في كل نتاجات الآداب والفنون، وفي أي عصر كان، ثمة ما يهبط ويتدنى، وثمة ما يعلو ويرتقي |
ثم، هل تجوز المقارنة -والمفاضلة تاليا- بين روايات نجيب محفوظ وقصص يوسف إدريس القصيرة مثلا؟ هل يمكن صرف النظر أو تظليل قيمة وأهمية النصوص المسرحية لسعد الله ونوس؟ لماذا ترانا لا نستطيع إغفال التجربة الشعرية لمبدعنا الكبير محمود درويش، والذي عنونت إحدى الصحف -بحق- ملحقها الثقافي المخصص لمنجزه بعنوان بالغ الدلالة والمصداقية: "زمن درويش" بذريعة أن العصر عصر الرواية وأنها باتت ديوان العرب الجديد؟
بل لماذا لا يمكننا بحال إدارة ظهر اهتمامنا للمنجز الموسيقي الذي قدّمه ويقدّمه لنا اليوم مارسيل خليفة؟ بل، زيادة في المفارقة، فإن أغنيات أم كلثوم وأسمهان وزكية حمدان ومحمد عبد الوهاب ما زالت تسمع -وبشغف- حتى من الجيل الجديد.
أما إن كان الأمر بذريعة أن معظم ما يكتب اليوم من قصص وقصائد ومسرحيات، وما يلحن من أغنيات، وما يرُسم من لوحات، لا ترتقي إلى مستوى الإبداع الرفيع… فإن في ميدان الرواية -كما نعلم جميعا وتشهد عليه إصدارات دور النشر- من "التخبيص" والافتعال والتسرّع والتعدّي على هذا الفن ما لا يتصوره عقل.
يأتي ذاك خصوصا في ظل تشجيع مؤسسات وهيئات ثقافية على كتابة الرواية حصرا، وعلى خلفية المسابقات والجوائز التي تنحصر بالإنتاج الروائي، بحيث اندفع القاصي وهرع الداني إلى كتابة رواية خلال أيام تعدُّ على أصابع اليدين -كما صرّح أحدهم- لا بسبب هوى لديه أو ميل أو موهبة، وإنما أملا بالحصول على الجائزة وقطف ثمارها المالية والإعلامية!!
لا علاقة بين تحقق القيمة الإبداعية لأي جنس أدبي أو لون فني وبين "الموضة" الدارجة في هذا العصر أو ذاك، إذ في كل نتاجات الآداب والفنون، وفي أي عصر كان، ثمة ما يهبط ويتدنى، وثمة ما يعلو ويرتقي.
غير أن الإبداع يبقى هو الإبداع، والقيمة تبقى هي القيمة بصرف النظر عن الجنس الأدبي أو اللون الفني، بما في ذلك "فن الطبخ وأنواعه" الذي ارتأت إيزابيل الليندي أن تخصّص له كتابها "أفروديت" في جملة كتبها الأدبية الصادرة.
_____________
قاص وكاتب سوري