إعادة التفكير في الخلافة.. هل يمكن حقا تأسيس قوة إسلامية عُظمى؟

تبدو جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعات الحركة الإسلامية، وتنظيمها الأم الذي تفرَّعت عنه معظم حركات "الإسلام السياسي" في العالم العربي بأشكالها المعتدلة أو الراديكالية، تبدو اليوم تحت حصار خانق مع تنظيم "متفسِّخ" وتصوُّرات مُشوَّشة، وذلك بعدما تلقَّت الضربة الأقوى في تاريخها على يد الدولة المصرية ومؤسساتها العسكرية إبَّان انقلاب يوليو/تموز عام 2013، الذي يوصف بأنه الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.
بعد مُضي ما يقرب من قرن على إلغاء "الخلافة" على يد "مصطفى كمال" (أتاتورك)، بدا وكأن كل تجارب "الحركة الإسلامية" قد فشلت، سواء صعدوا للسلطة بالانتخابات أو عبر انقلابات، وسواء شاركوا في السياسة أو أحجموا عنها، وسواء كوَّنوا أحزابا سياسية أو ميلشيات عسكرية، وسواء فصلوا الدعوي عن السياسي أو دمجوا بينهما.
في هذا السياق، أتى كتاب "استعادة الخلافة: تفكيك الاستعمار والنظام العالمي"، الذي أعاد فيه "سلمان سيد"، أستاذ النظرية الاجتماعية وفكر ما بعد الاستعمار بجامعة "ليدز" البريطانية، التفكير في مؤسسة الخلافة عبر تفنيد الأطروحات المُروِّجة لاستحالة عودة "الخلافة" بوصفها مؤسسة سياسية، وتقويض وتفكيك المفاهيم الأساسية التي هيمنت على الجدال بشأن "الخلافة" منذ إلغائها. وقد صدر الكتاب عن "الشبكة العربية للأبحاث والنشر" في بيروت عام 2018 بترجمة محمد السيد بشرى.
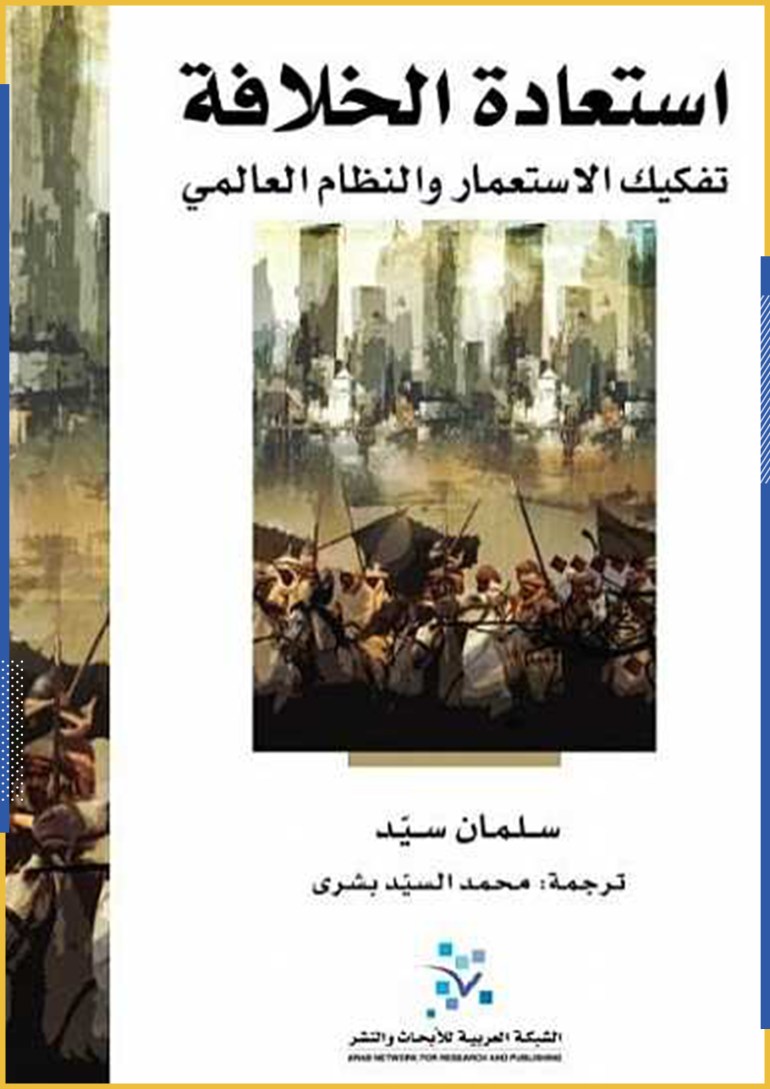
يأخذ الكاتب قُرَّاءَه في رحلة طويلة حول "الخلافة"، منتقلا من مساحة السياسة الشرعية والتأريخ التقليدي للخلفاء إلى فضاء جديد مشترك بين مجال النظرية السياسية وفكر ما بعد الاستعمار ودراسات الهوية، فاتحا بذلك باب النقاش حول الخلافة بوصفها فكرة سياسية وحدودها وإمكاناتها الواقعية، وما يمكن أن تعنيه "الخلافة" سياسيا للمسلمين. ورغم أن الكتاب لا يُقدِّم برنامجا سياسيا ولا خططا آنية أو مستقبلية، فإنه يطرح إستراتيجيات بوسعها أن تُعيد للحركة الإسلامية مركزيتها. فهل يُمثِّل كتاب "استعادة الخلافة" مُسوَّدة مانيفستو أو بيان لعودة الحركة الإسلامية إلى الساحة السياسية مجددا؟
"الكينونة المسلمة".. من التشرذم والشتات إلى انبعاث جديد
لا يبني سلمان أطروحته حول استعادة "الخلافة" على نص ديني يفرض ضرورة تاريخية، ولا حتى على وضع تاريخي، بل على إعادة النظر في وضع المسلمين اليوم حول العالم. فمنذ خروج القوى الأوروبية من العالم الإسلامي، وظهور النظم السياسية التي يصفها بـ"الكمالية" نسبة إلى كمال أتاتورك؛ هاجرت أعداد كبيرة من المسلمين نحو أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، مما شكَّل حالة من الشتات والتشرذم. وفي نظر المؤلف، يظهر ذلك الشتات عندما ينزاح شعب مكانيا لكنه يستمر في سرد هويته من منظور ذلك الانزياح المكاني، ومن ثمَّ تظهر الحاجة إلى إيجاد مفردات لوصف تلك المجتمعات سياسيا وثقافيا، وهي مفردات تتجاوز حدود نموذج "الدولة"، لأنه في داخل هذه المجتمعات ينفك الارتباط بين الأرض والشعب، حيث تصبح المُخيِّلة حول "الوطن" مُخيِّلة مشتركة تتشارك فيها تجمُّعات من جنسيات مختلفة، ويتفوَّق ترابطهم الثقافي على أي ارتباط قومي سابق، ومن ثمَّ ينفك الارتباط بين ما هو سياسي وما هو قومي.
بيد أن هذه "الأمة" المُشتَّتة ليس لديها أرض موعودة تُمثِّل مشروعها للخلاص، وليس وراءها مَن يُمثِّلها ويرعى مصالحها ويدافع عنها على ساحة السياسة الدولية. وبالنسبة إلى سلمان لا يكون خلاص المسلمين من واقعهم المتشرذم بالعودة إلى وطن، بل بالتجذُّر في العالم عن طريق إيجاد بنية سياسية شاملة قادرة على ربط المسلمين بصفتهم مسلمين بالمجتمع الدولي، والخلافة -في نظر سلمان- هي المؤسسة التي تُبشِّر بتجذُّر كهذا سيحل أزمة الاغتراب التي يعيشها المسلمون حول العالم، بل ويذهب سلمان إلى أن دعوات "الخلاص الفردي"، أي الدعوات التي تقول إن خلاص المسلمين في العودة إلى اتباع منهج النبي ﷺ وترك الدنيا، هي دعوات تُمثِّل المفهوم الليبرالي للخلاص الذي يناقض ما هو "سياسي"، حيث إن الخلاص الفردي لا يمكنه أن يكون أساسا للعمل الجماعي، ولذا لا يمكنه أن يكون مصدرا للسياسة.
وفقا لسلمان، فإنه إذا نُزع عن الإسلام صفته السياسية فسيفقد أُطره الكلية، وهو أمر يناقشه المؤلف نقاشا موسَّعا، فيقول إن القرآن الذي نُزعت منه صفته السياسية يفقد قدرته على إثارة مشاعر قرَّائه، ولن يستطيع أن يقود المسلمين نحو الأخلاق أو القيم المطلقة للحق والعدل، بل سيكون محض مصدر آخر للأخلاقيات ليس إلا. فلا يمكن نزع السياسية من الإسلام، وإلا فلن يكون بوسع المسلمين فهم كل تلك السياقات والجدالات السياسية في القرآن، بدءا من قصة فرعون ومرورا بـ"غُلبت الروم"، وصولا إلى السيرة النبوية التي لم تنفصل يوما عن التاريخ العالمي.

يستند المؤلف في طرحه إلى أفكار كلٍّ من سيد قطب وعلي شريعتي حول أن الأمة المسلمة ليست مُكوَّنة من "روابط الدم أو الأرض"، بل إن مكمن وحدتها الوحيد هو رؤيتها المشتركة للعالم التي تتكوَّن عبر قراءة القرآن، ولا بد أن تتجاوز الفردية وتُشكِّل رابطا بين المسلمين كافة بغض النظر عن المسافات بينهم، وبغض النظر عن كونهم أحياء أو أمواتا، إذ إن "الكينونة المسلمة" إرث ممتد عبر الزمان والمكان على حد قول سلمان، وهو إرث يتصل ماضيه بحاضره، أما مستقبله فمحاولة الامتثال لسيرة النبي ﷺ والدولة التي أقامها، وليس العودة إليهما. ولكن كيف يمكن أن تكون هذه الرؤية حاضرة في حياة الأمة المسلمة ومُمهِّدة لاستقلالها المنشود وعودة مؤسسة الخلافة في ظل سيطرة منطق "الاستحالة" ومفاهيمه ذات الارتباط الليبرالي، مثل النسبية والديمقراطية والعلمانية؟
إعادة التفكير في الخلافة
يُقسِّم سلمان سيد كتابه إلى قسمين، ويحاول في القسم الأول أن يُقدِّم خطا تفكيكيا لإعادة التفكير في المفاهيم التي سادت ساحة النقاش السياسي طيلة قرن من الزمان، وسيطر منطقها على أي خطاب حول الهوية والسياسة والخلافة. ويتناول المؤلف هُنا مفاهيم الليبرالية والديمقراطية والعلمانية والنسبية تناولا تفكيكيا بحثا عن مساحة لوجود مستقل "للكينونة المسلمة" على حد تعبيره. وفي هذا السياق، يرى سلمان أن الليبرالية تنظر إلى الدين كما نظرت إليه أوروبا المسيحية بتاريخها الدموي، مُشبها أوروبا الحديثة وحملاتها العسكرية بالحملات التبشيرية التي انطلقت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحت دعوى التحرير والتنوير. وفي حين أن الحملات الاستعمارية التبشيرية أبادت الكثير من سكان أفريقيا وآسيا والأميركتين في مجازر إبادة جماعية، فإن الإدارات العلمانية الليبرالية تستخدم الأقليات الدينية في أفريقيا وآسيا لخلق حالة من الصراع الطائفي الممتد حتى الآن.
ليست مرجعية الدولة، سواء دينية أو علمانية، هي القضية بالنسبة إلى سلمان، بل المُعضلة هي كيف نتصوَّر الدين وعلاقته بالدولة والمجتمع، حيث تنزع الليبرالية إلى فرض تصوُّر عن الدين "تنويري-غربي" في جوهره وتسعى ليُعمَّم على العالم كله، ومن ثمَّ يصبح كل ما هو غربي عالميا وصالحا لكل زمان ومكان، ويصبح رفضه نوعا من التخلُّف. ويتكرَّر الأمر نفسه في النقاش حول الديمقراطية، فالديمقراطية ليست الترجمة الحرفية لـ"حكم الشعب"، بل تحتوي على مضامين دلالية أكبر من ذلك، وهي ليست مجرد "نظم حكم رشيد"، بل نظم "تلاعبية" تسمح للأموال والبروباغندا أن تتلاعب بالمصير السياسي لشعوبها، وهو ما يجعلها في نظر المؤلف بمنزلة تصنيف لما إذا كانت الدولة مؤيدة للغرب أم لا، مما يُفسِّر لماذا يتوافق الغرب مع بعض النظم الاستبدادية في البلاد العربية، ويُفسِّر الانقلابات التي دبَّرتها الولايات المتحدة على التجارب الديمقراطية في بضعة بلاد نامية طمحت إلى الاستقلال، كما يُفسِّر الدور الذي لعبته بعض النخب الليبرالية والعلمانية في تأييد الاستبداد.
إن الصورة التي بناها الغرب عن نفسه، بوصفه ديمقراطيا وليبراليا وعلمانيا ومناصرا للحريات ومحاربا للإرهاب والرجعية، مبنية في جزء منها على أن يبقى عالم المسلمين في صورة مُعاكِسة ضمنيا، ومن ثمَّ تصبح تلك الدول الكمالية، على حد وصف سلمان، تجليا لقطيعة ذات ثلاثة مستويات؛ فهي قطيعة مع الماضي الثقافي الإسلامي للأمة، وقطيعة بعضها مع بعض، لأن كل واحدة منها يبحث حاكمها وحاشيته عن مصالحهم الشخصية، وقطيعة على المستوى الأفقي المجتمعي، إذ تلعب تلك الدولة على خلق الطوائف التابعة لها وتأجيج الصراعات مما يُفتِّت النسيج المجتمعي.

لذلك يعود المؤلف مرة أخرى إلى الرؤية التي يجب أن تكون مشتركة لدى جميع أفراد الأمة المسلمة، إذ يُقدِّم القرآن بصفته النص المحوري في حياة المسلمين تحديا كبيرا لقرائه، ويجعلهم يُفكِّرون في أساليب حياتهم ومآلاتها، وكيف يمكنهم أن يكونوا راشدين على هُدى من الوحي الإلهي والمُثُل الأخلاقية التي يُقدِّمها. وفي داخل هذا السياق، لا بد أن يكون التباين بين المسلمين ومناهضيهم تباينا سياسيا يعطي معنى للحياة ذاتها، وهذا المعنى هو التطبيق الحي لفهم القرآن، لا بوصفه برنامجا زمنيا أو مجموعة قصصية أو أوامر إلهية، بل بوصفه منهجا شاملا يرتقي به الإنسان.
لا يطلب سلمان أن يتحوَّل التديُّن إلى أيديولوجيا، بل إلى إستراتيجية تستند إلى معايير الإسلام وأخلاقه، دون أن ترفض الآخر على أساس ديني أو ثقافي، بل تتدافع معه على أساس سياسي. وعند التفكير في مؤسسة الخلافة بهذا المنطق، لا ينادي سلمان ببناء دولة مثالية (طوبيا)، ولا يستلزم أن تكون أخلاقية بالكامل، ولا يستلزم أن تُمثِّل جميع المسلمين، بل يرفض سلمان أن تقوم هذه الدولة بتطبيق الشريعة عبر تحويلها إلى قوانين مُقتَبَسَة من الفقه الإسلامي، ويدعونا سلمان بالأحرى إلى التفكير في مؤسسة الخلافة سياسيا. وهُنا يطرح سلمان خمسة معانٍ يمكن التفكير من خلالها في الخلافة سياسيا.
المعنى الأول هو أن تعني الخلافة دولة تتطابق فيها حدود الأمة تماما مع امتداد مجموع مسلمي العالم، وهو مفهوم ليس له نظير تاريخي، فحتى في صدر الإسلام أمكن وجود مجتمع للمسلمين في الحبشة، بعيدا عن سلطة الخلافة المباشرة. ومن ثمَّ يوجد شكل آخر أكثر استساغة هو أنها الدولة المسلمة الوحيدة والمركزية وإن لم تشمل جميع المسلمين، مما يجعلها شبيهة بالحالة التي سادت منذ النهاية الناجحة لحروب الردة وحتى الدولة العباسية، أي أن تعود مؤسسة الخلافة دولة لها قيادة روحية على المسلمين، وهو أقرب إلى ما اقترحه عبد الرحمن الكواكبي وجمال الدين الأفغاني، وهذا هو المعنى الثاني. أما المعنى الثالث فهو رؤية الخلافة بوصفها دولة تمارس دور القيادة للمسلمين، أي دولة لديها أدوات سياسية تحاول من خلالها مراعاة مصالح المسلمين في العالم كله، دون أن تدَّعي كونها الدولة الإسلامية الوحيدة. أما المعنى الرابع للخلافة فيكون بإبراز تماسُكها الداخلي بدلا من علاقاتها الخارجية مع باقي المجتمعات المسلمة، أي إنها دولة توفِّر مجتمعا صالحا وبيئة مناسبة لممارسة الهوية المسلمة. وأخيرا، التعريف الخامس للخلافة هو برؤيتها مجازا لقوة إسلامية ثقافية عظمى، دون شروط لحدودها الجغرافية أو عدد المسلمين داخلها أو إذا ما مَثَّلت دولة أم عددا من الدول المتحالفة معا.
في أغلب هذه المعاني التي يقترحها سلمان لا يستلزم أن تُعبِّر الخلافة عن خصوصية الدولة الإسلامية ذات الثقافة الوحيدة، بل يستلزم أن تكون عودة الخلافة هي الطريق إلى قوة إسلامية عظمى تسعى للاستقلال عن الثقافة الغربية، فماذا يعني المؤلف إذن بالقوة الإسلامية العظمى؟
البحث عن قوة إسلامية عظمى

"تخيَّلوا دولة أكبر من روسيا وأكثر اكتظاظا بالسكان من الصين مع اقتصاد أقوى من اقتصاد اليابان، ألن تتأهل هذه القوة إلى قوة عظمى؟ ليست هذه الدولة مجرد ضرب من خيال، بل ظهورها ممكن إذا تمكَّن الأعضاء السبعة والخمسون لمنظمة التعاون الإسلامي من تحويل تكتُّلهم المتقلقل إلى بنية سياسية شاملة. إن دولة كهذه ستمتلك موارد زراعية كافية لتغذية شعوبها، وموارد مالية كافية لتمويل تنميتها الاجتماعية-الاقتصادية، وسيساعد الاقتران بين الدول ذات الأيدي العاملة الكثيفة والدول التي تمتلك رؤوس الأموال على تحفيز نمو كهذا، أما القدرات العسكرية المُجتَمِعة لتلك الدول فستكون هائلة"
هكذا يحاول سلمان سيد فتح أفق الخيال حول امتلاك المسلمين لقوى عظمى، حيث يُعرِّف القوة العظمى بأنها أقوى الأعضاء المُشارِكين في النظام الدولي، الذين يحفظون عادة توازناته وقيادته. إذن القوة العظمى هي تلك الدولة (أو الدول) القادرة على صياغة قواعد النظام الدولي بدلا من مجرد الانصياع لها، بيد أن امتلاك هذه القدرة والحرية من أجل المناورة يعني أن هذه الدولة العظمى لا بد لها من امتلاك قوة عسكرية كافية لردع الإكراه الذي ستواجهه من قِبَل القوى العظمى الأخرى.
هل يمكن للمسلمين بناء نظام سياسي يملك صفة الدولة العظمى؟ يناقش المؤلف الإجابات المحتملة لهذا السؤال في سياق تفكيك منطق الاستحالة، وبناء خيال سياسي جديد يسمح باستعادة مؤسسة الخلافة بوصفها مشروعا لبناء "الاستقلالية المسلمة" وإصلاح العالم وتحريره من السيطرة الغربية. ومرة أخرى، لا يُقدِّم سلمان في كتابه برنامجا سياسيا أو أيديولوجيا، كما أن الخلافة والدولة العظمى التي يتحدَّث عنها ليست كيانا جيوسياسيا، بل عملية بناء أفق يُفكِّك الاستعمارية عبر إعادة تشكيل مفردات مفاهيمية جديدة تتملَّص من المركزية الأوروبية، وتسترجع الأمل بتحوُّل سياسي وثقافي قادر على مساعدة المسلمين في التحرُّر من مأزقهم الحالي. ولذا، في نقاشه حول إمكانية بناء دولة عظمى للمسلمين تُعبِّر عنها مؤسسة الخلافة، يبدأ سلمان بتقويض الدعاوى التي تتحدَّث عن تأصُّل الفُرقة والاختلاف وعدم القدرة على خلق ترابط سياسي استنادا إلى الكينونة المسلمة، التي لا تختلف في نظره عن إمكانية الترابط السياسي استنادا إلى الكينونة الصينية أو البريطانية.
وثمة مجموعات أربع من الحجج التي تُقدَّم لإثبات استحالة اتحاد المسلمين في هيئة دولة عظمى وتعليل عدم قدرتهم على الترابط السياسي والاقتصادي. تتلخَّص الحجة الأولى في أن طبيعة الاقتصاديات في الدول ذات الأغلبية المسلمة مُوجَّهة نحو التبادل الاقتصادي مع الغرب أو الشرق، ويصعُب توجيهها بين البلاد المسلمة وبعضها، مما يعرقل محاولات الاندماج الاقتصادي، وبدونه ستواجه مشاريع الوحدة السياسية عقبات لا يمكن تخطيها. غير أن ما يعرقل هذا الاندماج في الحقيقة هي النخب الحاكمة، وهو ما يقودنا إلى المجموعة الثانية من الحجج المُتعلِّقة بالطبيعة "التافهة والمرتشية الاستئثارية" لتلك النخب، التي تَحُول دون التعاون الإسلامي-الإسلامي. ويذهب سلمان إلى أن هذه الطبيعة المتدنية للنخب لا تمنعها من التعاون إذا تعلَّق الأمر بملفات الأمن ومحاربة الإرهاب على النمط الأميركي كما شهدنا طيلة العقدين الماضيين.

المجموعة الثالثة من الحجج هي توجيه اللوم في مسألة إخفاق الوحدة على التنوُّع والانقسامات الطائفية والإثنية العميقة، التي يُقال إنها متجذِّرة في المجتمعات المسلمة، لكن سلمان سيد يردُّ قائلا: "مَن قال إن درجة التنوُّع في الدولة ذات الأغلبية المسلمة أكبر من التنوُّع في الصين أو الهند أو أوروبا؟". وهُنا تأتي المجموعة الرابعة من الحجج، التي تدور حول الطبيعة المُصطنعة لأغلب الدول ذات الأغلبية المسلمة، إذ يقول سلمان إن الدولة الأوروبية نفسها دولة مُختَرَعَة إلى حدٍّ كبير، لكنها نجحت في صناعة أغلبيات قومية عبر ذاكرة جمعية وهوية وطنية، وهو ما فشلت فيه أغلب الدول ذات الأغلبية المسلمة، أي إن الوضع الحالي الذي تُلام فيها الحدود المُصطنعة والتداخل العِرقي والطائفي لا يَحُول دون تحقيق هدف الدولة الإسلامية المنشود.
إذن، يخلص المؤلف إلى أن المشكلات التي تواجه المسلمين، سواء في بلادهم أو خارجها، لم تنجم عن قصور ثقافي أو علمي، بل عن الضعف السياسي الذي فرضته عليهم الأنظمة "الكمالية" المستوردة، وهو ما يدفعه إلى الدعوة لبناء مؤسسات سياسية ذات هوية إسلامية. فما شكل النظام الإسلامي الذي يتخيله سلمان سيد؟
شكل النظام الإسلامي المُمكِن
لا يمكننا أن نصف نظاما سياسيا بأنه إسلامي لمجرد أن علم الدولة يحمل "شهادة التوحيد" أو عبارة "الله أكبر"، أو حتى لمجرد أن الدستور ينص على أن "الإسلام دين الدولة والشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع"، فما دامت البنية السياسية والاقتصادية لتلك الدولة تنزع إلى إنتاج ذوات لأفرادها متناقضة مع الإسلام بواسطة مؤسساتها القانونية والتعليمية والاقتصادية، فإنها لا تستحق لقب الدولة الإسلامية. ويُلخِّص المؤلف محاولات ترسيخ الهوية المسلمة مؤسسيا طيلة القرن الماضي في محاولتين، أولاهما محاولة الانقضاض على السلطة وتطبيق الشريعة، وثانيهما محاولة بناء "اقتصاد إسلامي". بيد أنه يُقِرُّ بأن المحاولتين فشلتا، وإن ركَّز في كتابه أكثر على "الاقتصاد الإسلامي" باعتباره وسيلة إستراتيجية لترسيخ الهوية الإسلامية.
يرى سلمان في الاقتصاد الإسلامي وسيلة بديلة لتنظيم الاقتصاد الوطني تقوم من خلاله التقاليد الإسلامية بضبط الإنتاج والاستهلاك على أساس محاولة توطيد القيم الدينية وروح نصوصها القرآنية والنبوية. ويُرجع المؤلف ظهور مصطلح "الاقتصاد الإسلامي" بوصفه اقتصادا متمايزا عن الأنظمة الأخرى إلى عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، حين أصدر أبو الأعلى المودودي عام 1947 كتابه المهم "مُعضلات الإنسان الاقتصادية وحَلُّها في الإسلام"، الذي رسم فيه ملامح ما أصبح فيما بعد "الاقتصاد الإسلامي". وقد رأى المودودي أن مشكلة الاقتصاد المعاصر إخلاله بالتناغم الاجتماعي، فالنظم الاشتراكية تجعل الاقتصاد شيئا محوريا يأتي كل شيء من بعده ومتأثرا به، والنظم الرأسمالية تُطلِق العنان لغرائز الإنسان التملُّكية والاستهلاكية والاحتكارية. ولذا، رأى المودودي أنه إذا كان للإسلام أن يؤدي دورا في المجال العام، فلا بد له أن يُقدِّم نفسه بديلا عن الرأسمالية والفاشية والشيوعية.
يقول سلمان إن مشروع الاقتصاد الإسلامي مبني على ثلاث دعاوى رئيسة. أولا، يدَّعي النظام الإسلامي بأن غياب الربا (الفائدة) سمة مميزة للاقتصاد الإسلامي، ومن ثمَّ تصبح إزالته ضرورة لتأسيس اقتصاد إسلامي. وثانيا، يُحدِّد الاقتصاد الإسلامي موضعه بوصفه طريقا ثالثا بين تجاوزات الاقتصاد الحر المرتبطة بالرأسمالية وسلطوية التخطيط المركزي الاشتراكي، فالاقتصاد الإسلامي يُمهِّد للمساواة الاجتماعية دون الاضطرار إلى سلطوية برامج التوزيع تحت سيطرة الدولة. وثالثا، يدَّعي مشروع الاقتصاد الإسلامي أنه يستند إلى حسٍّ شامل للرفاه ذي العناصر المادية والروحية التي تُحقِّق العدالة الاجتماعية والمساواة والتناغم.
بيد أن تطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي لم يأتِ على مستوى الدعاوى والتوقُّعات، فقد ركَّز على ثلاثة مجالات فحسب، هي تحريم الربا، وتأسيس نظام مصرفي إسلامي، وإدارة الدولة للزكاة. ومع التطبيق التدريجي البطيء والتخبُّط والضعف السياسي؛ فشلت كل تجارب الاقتصاد الإسلامي. ويذهب سلمان إلى أن الاقتصاد الإسلامي لم يؤسِّس لنفسه الأساس النظري اللازم ليكون بديلا عن "الأرثوذكسية الرأسمالية" أو خصمها الاشتراكي. ورغم ذلك، يواصل سلمان نقاشه حول أهمية "الاقتصاد الإسلامي" ودحض دعاوى عدم وجوده، فيقول: "قد لا تكون هناك طريقة إسلامية لبناء سيارة أو مصيدة فئران، ولكن ليس هناك سبب لئلا تكون هناك طريقة إسلامية ثقافية. وحتى إن استنتجنا بأن الرغبات الإنسانية قد تكون لا نهائية، فذلك لا يقتضي بأنها عالمية (إلى درجة تجاوزها للمساحة الثقافية). ويوضح ذلك مثال ’روبِنسون كروزو‘، إذ إن صاحب المزرعة الواسعة الإنجليزي الذي تحطَّمت سفينته لم يفقد كينونته الإنجليزية، ولا صفة كونه صاحب مزرعة واسعة. وقد احتاج كروزو إلى القيام بنشاطات تضمن وجوده على الجزيرة المهجورة لموازنة رغباته مع الوسائل المتاحة له. لكن مساعيه للمأوى والطعام تتشكَّل جميعا من خلال فهمه الثقافي لماهية الطعام والمأوى، وماهية الموارد والخبرات المتاحة له لإنتاج البضائع والخدمات التي يحتاج إليها، فربما غادر كروزو المجتمع الإنجليزي، لكن قيمه وممارساته لا تغادره وتستمر في تشكيله حتى على جزيرة مهجورة، وعلى سبيل المثال، يغرس كروزو صليبا يحمل تاريخ وصوله إلى هناك".
يخلص سلمان إلى أن النشاط الاقتصادي برمته يصبح ذا معنى فقط فيما يتعلق بدور هذا النشاط داخل العلاقات الثقافية والاجتماعية، فليست مشكلة الاقتصاد الإسلامي أنه لا يتبع المعيار العالمي التجريدي لما يُعَدُّ غاية الاقتصاد، بل مشكلته إنه يرتبط بمفهوم الإسلام الذي يسعى لتقرير مشروعه الاقتصادي على أسس مضادة للمُثل الرأسمالية. وقد باتت حجة سلمان في منتهى الوضوح بعد حرب أوكرانيا، إذ سارعت أغلب المؤسسات والشركات الاقتصادية إلى تبنِّي موقف سياسي أيديولوجي وثقافي صريح، رُغم أنها ادَّعت من قبل عدم وجوده بالمؤسسات الاقتصادية والربحية. إن التحدي الذي يطرحه سلمان لتأسيس هوية إسلامية داخل نسيج الدولة والمجتمع عبر إستراتيجية الاقتصاد الإسلامي تحدٍّ خطير لكنه مزدوج، فهو يرسم من جهة خريطة الرحلة من الإسلام إلى الإسلام الثقافي، أي تطبيق ما هو مستوحى من الإسلام، ويحاول من جهة أخرى تجنُّب المثالية التي قد تجلب الكوارث أو تنحدر إلى الفساد، وأقرب مثال على ذلك هو شركات توظيف الأموال التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي وكادت أن تصبح بديلا للبنوك. ويرى سلمان أن الاقتصاد الإسلامي بالنسبة إلى "الإسلاميين" إستراتيجية فعالة في ظل غياب السلطة وقوة الدولة، أي إن الاقتصاد الإسلامي إستراتيجية لمراكمة هيمنة الإسلاميين بالمجتمع، ولكن ماذا يقترح سلمان لتحقيق تلك الهيمنة؟
هل يمكن أن تتجدَّد قوة الإسلاميين؟

في عام 1994، نشر "أوليفييه روا"، عالم السياسة الفرنسي البارز، كتابا لافتا للانتباه تحت عنوان "فشل الإسلام السياسي"، ثم أصدر "جيل كِبِل"، الباحث الفرنسي المتخصص في الحركات الإسلامية، كتابه "الجهاد: توسُّع الأصولية الإسلامية وأفولها وانحدارها" عام 2000، ومن بعدهما أصدر كلٌّ من "راي تَقِيَه" و"نيكولاس جفوسديف" عام 2004 كتابهما بعنوان "الظل المنحسر للنبي.. صعود وسقوط الإسلام السياسي". وتدور الفكرة الأساسية لتلك الكتب كافة حول مقولة إن الحركات الإسلامية فشلت أو إنها في طريقها إلى الفشل المحتوم في العالم العربي والإسلامي؛ بسبب عدم قدرة الإسلاميين على صياغة نموذج سياسي مقبول من المجتمعات التي يعيشون فيها، أو بسبب اتجاههم إلى ممارسة العنف بوصفه رد فعل على فشلهم في المعترك السياسي.
لكن السنوات التالية لصدور هذه الكتب أثبتت خطأ ما ذهبت إليه أو عدم دقته؛ حيث شهدت هذه السنوات صعودا كبيرا للحركات الإسلامية في المنطقتين العربية والإسلامية. وهو الأمر الذي جعل الدكتور بشير نافع يكتب عام 2015 مقالا بعنوان "هل نشهد فشل الإسلام السياسي؟"، الذي ذهب فيه إلى أن جماعة الإخوان وحركات "الإسلام السياسي" لم تنشأ نتيجة سقوط الخلافة عام 1924، رغم تأثير ذلك في نشأتها، بل نشأت نتيجة سياق أكثر تعقيدا للأزمات التي واكبت ولادة الدولة الحديثة "بالغة القوة والسيطرة والتحكُّم"، وهو السياق الذي ما انفك يستدعي قوى الحركة الإسلامية.
في هذا السياق، يُقدِّم سلمان سيد إستراتيجية لنجاح هذه العودة، بنقاشه حول "مشروع الهيمنة الإسلامي" الذي يمكن أن يُمهِّد الطريق لاستعادة مؤسسة الخلافة، الحل السياسي الفعلي في نظره للمأزق الحالي للمسلمين، حيث يذهب سلمان إلى أن مشروع الهيمنة الإسلامي الناجح هو المشروع القادر على الجمع بين الاقتصاد والثقافة والدولة ضمن نظام إسلامي ثقافي مُوحَّد، ويتم ذلك من خلال "استنطاق مطالب مُتنوِّعة وتعبئتها وتنسيقها ضمن برنامج عمل مُحدَّد مبني على القيادة السياسية والثقافية والفكرية، إذ يحتاج مشروع الهيمنة إلى بث البلبلة في صفوف نظام المعارضة ليُعيد ترتيبها ضمن غاياته وأهدافه، وإلى تأسيس ممارسات ومُنظَّمات وقيم تقود بتأكيد رؤيتها للعالم".

لا يدعو سيد إلى الخروج من "المعارضة" بشكلها المعتاد إلى شكل "أذكى" فحسب، بل يدرك جيدا أن أي محاولة لإعادة الهيمنة الاجتماعية سوف تواجه صورة الدولة الحالية التي تُوزِّع الهيمنة على فئات تابعة لها. ففي نظر سلمان ليست الدولة مساحة محايدة ومنفتحة، بل هي كيان مُنغلِق وإقصائي بالدرجة الأولى. بيد أنها دولة تفتقد إلى الشرعية، حيث تعتمد في بقائها على دعم القوى الخارجية، وهذه ثغرة يجب أن يبدأ منها مشروع الهيمنة الناجح، عبر القدرة على التعبير عن المطالب المُتنوِّعة وبشكل يتجاوز مصالحها المحلية، دون الصدام مع الجهاز المُعقَّد للدولة. ويرى سلمان أن الحركات الإسلامية الأنجح هي تلك التي أسَّست هيمنتها دون إسقاط النظام بتمرُّد عام، كما حدث في تركيا على سبيل المثال.
بيد أنه قبل ذلك، يلزم الحركة الإسلامية -بحسب سلمان- أن تُحدِّد إستراتيجيتها المستوحاة من الإسلام، عبر تأسيس "نموذج للسياسات يمكن ضمنه مفاوضة الصراعات حول المصالح والمطالب المتنافسة"، إذ إن فهم خريطة موازين القوى والتحرُّك من خلالها هي الإستراتيجية التي يقترحها سلمان، ففي نظره ما من طريقة ناجعة خارج حدود التاريخ أو الأمة لبناء هذا النموذج. ففي النهاية، لا تُمثِّل استعادة الخلافة خطابا أيديولوجيا ولا برنامجا سياسيا، ولا عودة أو حنينا إلى الماضي، بل تُمثِّل حشدا للمعاني حول كيفية انسجام مغامرة الإسلام ضمن العالم، أي قدرة المسلمين بوصفهم "إدارة جماعية" على صناعة تاريخهم الخاص، وعلى موضعة أنفسهم ضمن المستقبل العالمي وترسيخ شعورهم بهويتهم. أما مؤسسة الخلافة فلا يستلزم أن تكون مؤسسة أخلاقية مثالية، بل أن تكون قادرة على بناء عالم لا يكون فيه وجود المسلمين وجودا هامشيا، ومن ثمَّ فالخلافة دولة تُمثِّل ذاتية مسلمة عالمية، لا مجرد مؤسسة تاريخية، فهي تُمثِّل الإرادة والعزيمة الجماعية للأمة وقدرتها على بناء نموذج سياسي مستوحى من الإسلام.
__________________________________-
المصادر والمراجع:
- سليمان سيد، استعادة الخلافة: تفكيك الاستعمار والنظام العالمي، ترجمة: محمد السيد بشرى.
- شحاتة محمد ناصر: في نقد مقولة "انحسار الإسلام السياسي".
- هل نشهد فشل الإسلام السياسي؟

