التحولات والارتكاسات في مفهوم القوة
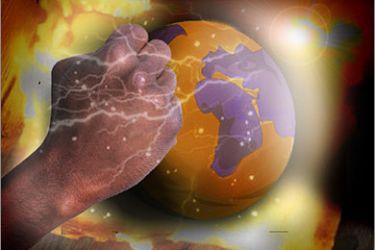
تستخدم إسرائيل مفهوم القوة بأشكال عفا عليها الدهر وعلى رأسها مفهوم القوة الغاشمة، أو مفهوم القوى بأقصى تجلياتها؛ وهي تريد اليوم أن تُحصّل بالتفاوض ما لم تحصّله بالحرب عن طرق استخدام قاعدة الإلغاء؛ أي إلغاء المفاوض الآخر وفرض قاعدة المنتصر الكامل في معركة لم تهدأ وصراع لم ينته.
كما أن الأميركيين خرجوا عن تراث مفهوم القوة عبر القيام بأعمال عسكرية تجاوزت التلويح بالقوة إلى استخدامها المفرط أحياناً في النتائج المتصلة بالاستقرار والتوازن.
مع ذلك فإن العودة إلى قواعد لعبة القوة واستخدامها يظهر حالياً من خلال اعتماد لغة الحوار والعصا والجزرة، خاصة وأن الخروج من قواعد لعبة القوة قد أدى إلى مأزق في العراق. وهذا ما يعطي انطباعاً بأن تراث القوة أقوى عملياً من استخدامها أو غرور استخدامها.
| " العودة إلى قواعد لعبة القوة واستخدامها يظهر حالياً عبر اعتماد لغة الحوار والعصا والجزرة، خاصة وأن الخروج من قواعد لعبة القوة أدى إلى مأزق في العراق، وهذا ما يعطي انطباعاً بأن تراث القوة أقوى عملياً من استخدامها أو غرور استخدامها " |
ولهذا يستدعي الأمر بحث التطورات في مفهوم القوة في الصراعات، المعاصرة الذي لم يعد اليوم القوة المباشرة بقدر ما أصبح القوة غير المباشرة، ولم يعد إظهار القوة بقدر ما غدا تضمينها، فالقوة وفقا للتصور الإستراتيجي بتراثه الأعمق -بعيدا عن الارتكاسات الآنية الحالية التي تفرضها وقائع المرحلة الانتقالية من نظام عالمي إلى آخر- هي القوة المستترة والكامنة.
لقد بات واضحاً أنه تغيير مفهوم القوى تاريخياً حيث درج الفلاسفة على استخدام القوة وسيلة: فقد لا تقل فلسفة نيتشه في إرادة القوة أهميةً عن فلسفة صراع الطبقات والعنف كقافلة للتاريخ عند ماركس.
ويبدو أن الخيط الرفيع بينهما قائمٌ بالفعل، لكن الاختلاف الوحيد هو أن فلسفة ماركس استطاعت أن تجد تطبيقاً (ما)، إلا أن فلسفة نيتشه لم تستطع أن تجد تطبيقها اللهم إلا إذا اعتبرنا أن تجربة ألمانيا النازية واليابان الفاشية، تجسيدين لهذه الفلسفة.
ولكن إذا كانت فلسفة نيتشه أقرب إلى التطرف في إنتاج القوى واستخدامها دون إيجاد مبررٍ أخلاقيّ أو أيديولوجي لها، ولهذا فإن سرعان ما سقطت، فإن تجربة ماركس قد تأخرت في الوصول إلى نهايتها الحتمية.
ولقد تبين أن الغرب أيضاً قد غادر مفهوم القوة منذ مطلع السبعينيات إثر تجربة فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، وبات واضحاً في النظام العالمي السابق أنه انبثق باعتباره تجسيداً لإرادة الضبط على حساب إرادة الإكراه وكحالةٍ متطورة لنظام الهيمنة، أن القاعدة قد باتت هي ممارسة النفوذ دون الحاجة للقوة.
وإذا كان لكل قاعدةٍ شواذٌ فإن هذا لا يلغي أن المسار يشير إلى أفول فلسفة القوى، ويمتد إلى ما قبل انتهاء الحرب الباردة، بل إن الحرب الباردة نفسها ومن تسميتها تشير إلى هذا التوجه، الذي لم يبدأ بالتبلور إلاّ مؤخراً
ولعل في سقوط الاتحاد السوفياتي، بدون تدخل بالقوة من خارجه أو حتى من داخله ودون الحاجة إلى ملء فراغ القوى الذي نجم عن هذا السقوط وهي ظاهرةٌ غير مألوفة في تاريخ العلاقات التاريخية بين الأمم، وتكرار ذلك مع تفكك الاتحاد اليوغسلافي الذي اشتعل هذه المرة بنفسه وبنار الحرب الأهلية التي أكلته من الداخل، مثالاً آخر، حتى أنه يمكن أن يقال إن فراغ القوة الناجم عن امتناع القوى الخارجية عن التدخل هو الذي جعل الحرب الداخلية تندلع بضراوةٍ لم يسبق لها مثيل ولم تتوقف إلا بعد لأي.ٍ
حتى حرب الخليج قد جرى إخراجها لا على أنها حرب قوةٍ بل حرب عقوبةٍ على سياسة القوة وعلى فعل القوة، وأعطي لها لا شكل حرب إنما شكل لعبة حرب باعتبارها نموذجاً لحربٍ تكنولوجيةٍ بالأزرار دون صدام قوةٍ ودون التحام مباشرٍ على الأرض، وهكذا فإن المتغير الأساس في فلسفة القوة في النظام العالمي الجديد إنما هو الاكتفاء بالتهديد بالقوة بدلاً من استخدامها, حتى أننا نستطيع القول مع "باسكال بون فاس" إن غياب إرادة القوة لا يعني شيئاً في نهاية المطاف إلا تحاشي الرغبة في تحمل نتائج القوة.
وبالتالي فهو ضرب من (التشرنق) الإستراتيجيّ على الذات لتفادي عدائية العالم المباشرة والكلفة البشرية العالية لسياسات التدخل الخارجية، وهو ما يبدو أنه كدرس إستراتيجي تجاوزته الولايات المتحدة، في عملياتها في أفغانستان والعراق، ولكن النتائج التي تكرس الدرس نفسه تدفع الأميركيين إلى العودة عن سياسة القوة، ولكن إستراتيجية الخروج هي المأزق النوعي اليوم.
| " المعنى المطلق لمفهوم القوة كما كاد يشيع في النظام العالمي السابق لا يتسق مع واقع تفاعل القوة مع قوى أخرى، حيث تبدو الدولة قوية قياساً لدولة أخرى، وتبدو ضعيفة قياساً لدولة ثانية، ومع ذلك فإن هذا المعنى النسبي لم يعد كافياً " |
إن إرادة اللا قوة لا تعني نبذاً لمفهوم القوة بحدّ ذاته بل تعني تجنّباً لنتائج استعمالها المحتمل. والهدف هو حماية الامتيازات والإبقاء عليها وليس توسيعها وتكبيرها لأن وسائل أخرى كفيلةٌ بتحقيق ذلك. وإذا كان التعريف الكلاسيكي لقوة الدولة هو قدرتها على فرض إرادتها فإن تعريف القوة الحديث ليس في ذلك بل في إيجاد خيارات كثيرة لمنع إكراهات الآخرين وفرض إراداتهم على قوة الدولة.
إن المعنى المطلق لمفهوم القوة كما كاد يشيع في النظام العالمي السابق لا يتسقُ مع واقع تفاعل القوة مع قوىً أخرى، حيث تبدو الدولة قويةً قياساً لدولة أخرى، وتبدو ضعيفةً قياساً لدولة ثانية، ومع ذلك فإن هذا المعنى النسبي لم يعد كافياً إذ إن مقياس القوة ليس بمقارنتها لدى الآخرين بل بما يترتب على امتلاكها من نتائج.
إن المعنى الكلاسيكي للقوة الذي نجده في كتابات (كوتيليا) و(وتريتشكا) و(كيسنجر) هو نفس المعنى الذي ذهب إليه (جنتز) والذي يعني الثقل المعادل والذي لا ينفصل كمنهجية معرفية عن أحد مبادئ الثورة النيوتونية، ومفهوم القوة النيوتونيّ.
غير أن هذا المفهوم النيوتوني للقوة الذي ارتكس إليه الأميركيون مؤخراً، كان قد تسللت له ملامح مخالفة ليصبح مقياس القوة هو الأثر المترتب عليها، أي أن مقياس القوة هو في نتيجتها، فبمقاييس الكلاسيكيين كانت القوة الأميركية في فيتنام هي الأكبر لكنها قوة عقيمة، والقوة العسكرية السوفياتية في أفغانستان كانت متفوقة كما ونوعاً لكنها قوة "غير منتجة".
وهناك بعد آخر لا بد من التنبّه له في تحول دلالات مفهوم القوة، إذ إن تداخل الكيانات السياسيّة المعاصرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبروز "مفهوم الاعتماد" المتبادل، أدى إلى ظهور ترابط بين الكيانات يحوّل بحد ذاته (الترابط) إلى أحد مقومات القوة.
إذ إن التلاعب بالاعتماد المتبادل يجعل من الترابط عنصر قوة إضافية سواء أخذ هذا الترابط شكلاً بيولوجياً (مساهمة خصائص معينة لدى الأطراف لإنجاز خاصية جديدة على غرار مساهمة مجموعة من الجينات في بناء خاصية وراثية مميزة) أو ترابطاً نظامياً (على غرار تسلسل الذرات في جزئ معين) أو ترابطاً ميكانيكياً (على غرار انتقال الحركة في نظام آلي).
على أن تحولاً آخر في مفهوم القوة المعاصرة قد تترتب عليه سلسلة من النتائج، وهو الانفصال التدريجي بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية، إذ إن النظم الدولية القديمة قد كانت تستند لقوى عسكرية اقتصادية، بمعنى أن الدولة الأقوى عسكرياً تكون الأقوى اقتصادياً (روما، أو الإمبراطورية الإسلامية، أو بريطانيا الخ…) غير أننا نلاحظ انفصالاً بين بعدى القوة المذكورين ويكفي مقارنة القوة الاقتصادية لليابان أو ألمانيا مع الولايات المتحدة وروسيا، مع قواهم العسكرية، لإدراك هذا التحّول.
| " مفهوم توازن القوى الكلاسيكي يرى التفاعل الدولي كلعبة صفرية، بينما التوازن الجديد يراها ذات مضمون غير صفري تدعمه عملية التشابك المتزايد بين المصالح واتساع دائرة المصالح المشتركة " |
إلى جانب ذلك كله، فإن المتغير الرئيس في بناء القوة يعرف تحولاً، فقد كانت الملكية: هي معيار القوة، حيث تمركزت السلطة في المرحلة الأولى بيد ملاك الأرض والجنود ولكنها -كما يصفها توفلر- سلطة متدنية النوعية وذات مضمون سلبي، وفي المرحلة الثانية تمركزت القوة بيد أصحاب المصانع الذين شكلوا سلطة مبنية على الثروة وهي سلطة متوسطة النوعية وذات مضمون مزدوج سلباً وإيجاباً، أما المرحلة الثالثة التي نعيشها فهي مرحلة المعرفة وتتمركز بيد العلماء وهي سلطة ذات مضمون عال في نوعيته ويتسم بالإيجابية.
ويرى توفلر أن "التصادم بين القوى التي تجعل المعرفة أداة سلطتها و بين قوى الثروة سيكون أهم من الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية.
كذلك فإن مفهوم توازن القوى لم يبق بذات المعنى المتداول في الأدبيات الكلاسيكية، فالتوازن بدلالاته الكلاسيكية يعني قدراً من الانفصال بين الوحدات يتم قياس كل منها منفصلاً لتتم عملية المقارنة بينهما، فتوازن القوى بهذا المعنى يتضمن مفهوماً تجزيئياً لاشتراطه القياس على أساس الانفصال، كذلك فإن مفهوم توازن القوى يعني توازناً عن طريق القوة، بمعنى أن التوازن يعني السلام وعدم التوازن يعني الحرب، أي أنه توازن ذو مضمون عسكري إلى حد بعيد.
وبالمقابل، فإن مفهوم التوازن الناتج عن الترابط قد حلَّ محل المفهوم القديم، ففي الواقع الدولي المعاصر ثمة نمطان من المصالح، مصالح متناقضة، ومصالح مشتركة، وكلما اتسعت دائرة المصالح الثانية أدى ذلك لتوازنات دولية ليست ناتجة عن القوة بمفهومها السلبي بل عن "قوة المصلحة المشتركة".
إن مفهوم توازن القوى الكلاسيكي يرى التفاعل الدولي كلعبة صفرية، بينما التوازن الجديد يراها ذات مضمون غير صفري تدعمه عملية التشابك المتزايد بين المصالح واتساع دائرة المصالح المشتركة.
كذلك فإن توازن القوى الكلاسيكية هو توازن قلق لا يتضمن آلية ذاتية للتوازن، فبالعودة لتاريخ العلاقات الدولية نجد أن انسحاب أي وحدة من الوحدات الفاعلة في الكتل المتوازية كان يؤدي لاختلال التوازن وانهيار النظام، بينما نرى في بنية التوازنات الحالية قوة من توازنات مبنية على الكتل العسكرية وانتقالاً إلى توازنات مبنية على الترابط الاقتصادي، وتعتمد على المنافسة لا الصراع، كما أن ميكانيزمات التوازن أصبحت من خارج وداخل التوازن ذاته، وأصبح المجتمع الدولي عبارة عن شبكة من التوازنات المترابطة التي يؤدي اختلال إحداها إلى نهوض آليات التكيف في بقية منظومة التوازن هذه لضبط الاختلال.
إن انتقال العالم من تقانات الثورة الصناعية إلى تقانات الثورة المعلوماتية التي يبدو أنها تتوافق مع متحولات العالم السياسية قد ساعد في استحداث هذا التحول نحو الضبط العالمي باعتبارها (أن التقانيات) قد جعلت الجغرافية لا مكانيّة من ناحيةٍ والمكان غير زمانيّ من ناحية أخرى، لأن الانتقال المعلوماتي قد أصبح بسرعة الضوء عبر الأقمار الصناعية و بالتالي فقد أصبح “الحضور” ممكناً ولو عن بُعدٍ.
والمؤكد أن السباق لم يعد اليوم متركّزاً على اختصار المسافات، بل على تغيير منظومة التعامل مع الزمن على اعتبار أن الزمن هو في المحصلة النهائية (مفهوم).
| " إذا كانت وظيفة الأيدولوجية بمعنى من المعاني أنها أداة للوهم والتعبئة فإن النظام العالمي الجديد سيكون مرة بلا أوهام كبيرة ومرة بأوهام من قبيل أوهام المحافظين الجدد، أي إنه لن يخلو من الأوهام الصغيرة ولو إلى حين " |
وإذا ما تجسّدت النظريات الفيزيائية المنبثقة عن الفيزياء الكمومية كنظرية "إفرت" في الأمكنة المتوازية والأزمنة المتوازية ونظريات (كل شيء) والحديث عن أبعاد سباعية وثمانية…الخ، فإن التقانات المقبلة ستجعل من الزمان قيمة غير محققة الأمر الذي سيستدعي (أزمنة سياسية) جديدة، ومستتبعاتها اللاحقة على المستوى العلاقاتي في العمل السياسي الدوليّ.
والواقع أن هذا الأمر سيستدعي إشكالية جديدة، إذ إن الانتقال من جيل حاسوبيّ إلى جيل آخر يحدث في أقل من عشر سنوات مما يجعل (المفاهيم) والمنتظمات السياسية في حالة من التجّدد المستمر، وإلاّ فإنها سوف تجد نفسها في حالة (فوات) كامل عما تستدعيه حركة التقانة.
وإذا كان لكل نظام سياسيّ أيديولوجية ولو الصورية، وإذا كانت للأيديولوجيّة عطالتها التي تمنعها عن التغيير، فإن الأزمة الحقيقة التي سيشهدها النظام العالمي الجديد الذي يعيش الآن مرحلة التشكيل أنه ربما لا يتشكّل أبداً بالمعنى الستاتيكي للكلمة لأنه سيبقى في وضعيّة تشكّل مستمرة تتوافق مع التشكّل المستمر والتحولاّت الدائمة، الأمر الذي سيجعله في حالة انعدام الوزن أو الخلو من اللاأيديولوجية أو الارتكاس إلى أيديولوجيات للقوة المفرطة.
وإذا كانت وظيفة الأيديولوجية بمعنى من المعاني أنها أداة للوهم والتعبئة فإن النظام العالمي الجديد سيكون مرة بلا أوهام كبيرة، ومرة بأوهام من قبيل أوهام المحافظين الجدد أي أنه لن يخلو من الأوهام الصغيرة، ولو إلى حين. نقول إلى حين لأن العقلانية سرعان ما تعود لتفرض نفسها من جديد.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
