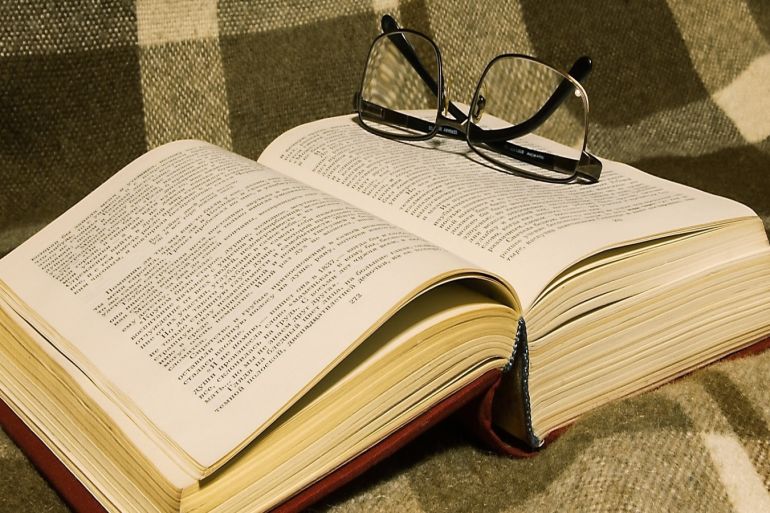مما حاك عدّة تساؤلاتٍ مؤرّقة في ذهني. هل يعتبر الاكتفاء بالكتب غير الأدبيّة وقاراً في عالم القراءة بينما يُنظر للنصوص الأدبيّة على أنها نصوصٌ من حقلٍ أرعن يأخذنا إلى لا مكان؟ هل ثمّة معيار يجعل من جمال الأدب ترفاً أو شيئاً كماليّاً أو سطحيّاً في عصرنا السياسيّ الدمويّ فيحرمنا منه؟ هذه المقارنة المغلوطة والتي يُصّر بعض الأشخاص على عقدها بين الفئة الأدبيّة وبين باقي الكتب ويسعون دائماً لوضع الأدب خصيماً للعلم. وكأن قراءة الأدب تعتبر نقيضاً لرحلة العلم والبحث والاختصاص. عشوائية التصنيف هذه تثير أعصابي. هذه الفئة ترى من قراءة الأدب نزوحاً صريحاً عن المعرفة ونزوة صبيانية. لم يُوظّفني أحدٌ محاميّة عن الأدب ولست أكثر قرّاءه إخلاصاً ولكنني أؤمن بأنه من الإجحاف أن يُرى الأدب على أنه نصوص مرصوصةً بالصور الفنيّة. واثقةً أيضاً بأن قراءته أنضج من كونها مجرد أسلوب للتسليّة وتمضية الوقت.
اليوم ما عدت أمضي ساعاتٍ في قراءة الأدب لأجد قصتي مختبئةً بين السطور وأتتبعها لأسرق الحل بتحاذقٍ مراوغ للقدر. ولا أقرأ الأدب لأجرّب حلولا عثرت عليها في رواية أو في متن قصيدة وأسقطها على مشاكلي. إنني أقرأه لأقصّ حكايتي الخاصة بلساني أنا وعبر قاموسي الخاص.
| المجد كل المجد للكتب التي من فرط سعادتنا بها قبّلناها واحتضنّاها دون أن نعلم أنها هي مَن تحضننا. وأنها مَن تحملنا رغم استقرارها بين أيدينا. المجد للكتب التي لا تبخل علينا بالدهشة والأسرار والتلميحات. |
لم تمنحني الكتابات الأدبيّة زوجَ عيونٍ جديدة لأغدو جسداً يمتلئ بالعيون يصلح لأن يكون دوراً بطوليّاً مخيفاً في فيلم رعب. لم يهبني الأدب عيونا غير عيوني التي ولدت بها. بل وهبني بصيرة بفضل التصورّات التي أنسجِها عبر قراءتي. لا حاجة بالتقاط معلومة جوفاء ما لم أحوّلها لتصوّرٍ ومفهومٍ ذي معنى ليشكّل جزءًا من خريطة أيامي.
أعتبر الأدب وسيلة صمود ومحاولات للثبات في هذا الزحام وتحت ضغط هذه الحياة. يمكن أن يكون الأدب شيئاً خفياً يساعدني لأتجاوز محطاتي السيئة. لست أدّعي أن الكتابات الأدبيّة محطة الخلاص النهائية ولا حتى سرداباً يفضي إلى الفردوس بل فسحةً في المعترك وجمالاً مستساغاً وسط القُبح.
باب الأدب مهّد لي طريق المعرفة ومنحني هذا الدافع الخفيّ لأعرف عمّا أقرأ ومن هذا الذي يُذكر في السطور ولِمن تعود هذه الرمزيّة. وما هي البلاد التي تستحق أن تغدو موقعاً لهذا الحدث في القصيدة؟
كان المحرّك لأن أتخيّل ما أقرأ. الخيال الذي أنقذني فيما بعد من ثُقل الواقع ومأساة الحاضر.
قبل الأدب كان اهتمامي بالقضية الفلسطينية لا يغدو أكثر من كونه شعارات هوجاء يقودها حماسٌ دون وعي واضح وبلا أيّ معرفة تُذكر. وبعد غسان كنفاني وحسين البرغوثي باتت قراءتي ممنهجة. وبتّ للمرة الأولى أترجم مفهوم الوطن وأجد له نظيراً في عقلي. حينها قرأت التاريخ وفاجعة النكبة والثورات ضمن السياق.
من خلاله تعرفّت على الأندلس وجدران الحمراء وقبلها لم أمتلك أن أعرف عنها عدا أنها بقعة خضراء ومليئة بأفرقة كرة القدم. اكتشفت مترجميّ المفضلين وأدركت لماذا ترتبط نهضة الأمم بالكتابة ترافقها دائماً الترجمة كتوأم سياميّ. عرفت إيزابيل الليندي وجنونها وديستويفسكي ونفسية الإنسان المعقدة. ميلان كونديرا ورسول حمزاتوف والمتنبيّ ورفاقه.
إنني أستطيع القول إن الأدب لم يكسبني معرفة مباشرة بل على العكس أثبت لي بأن هذه ليست مهمته ولا مهمة أي شيء مهما كان موقعه أن يعطينا معرفة سريعة جاهزة ومغلّفة تحفّر الملل فينا لتجعلنا أشخاصا نغتّر بأننا موسوعة بدلاً من أن نصارح أنفسنا كوننا مستهلكين جشعين.
لم أقرأ إلّا القليل ولم أغترف من النهر إلاّ غَرفة. طامعةٌ بالمزيد من النصوص التي تنتظرني لأقرأها. لماذا نقرأ الأدب؟ لا إجابة واحدة شافية ولكنني أرتاح لفكرة مفادها ببساطة أن الحكايات التي لن يتنسَّ لنا خوضها وبلدان الله التي نجهل طبيعتها بإمكاننا أن نحظى على أقل تقدير بلمحة عنها من خلال القراءة.
المجد كل المجد للكتب التي من فرط سعادتنا بها قبّلناها واحتضنّاها دون أن نعلم أنها هي مَن تحضننا. وأنها مَن تحملنا رغم استقرارها بين أيدينا. المجد للكتب التي لا تبخل علينا بالدهشة والأسرار والتلميحات عن معنى الجنّة في الأرض.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.