حكيم بلعباس.. همزة الوصل بين السينما والمجتمع

نزار الفراوي-الرباط
ولأن هذا الرهان عبر عن نفسه منذ الأعمال الأولى للمخرج، وتوطن بشكل أكثر عمقا ونضجا بتوالي تجاربه بين الفيلم القصير والطويل صح حينئذ الحديث عن مشروع بادي المعالم يعي ذاته ويشق له مجرى في ساحة الإنجاز السينمائي بالمغرب.
بهذا المعنى، فإن حكيم بلعباس "يكرر نفسه"، لكن بالمعنى الإيجابي الذي يحيل إلى مركزة الاشتغال على مواضيع بعينها، وبمقاربة فنية تتأصل من عمل لآخر، هو نفسه يعلن إيمانه بمقولة "هي الحكاية ذاتها، وما يتغير هو المحكي".
ويعتبر كتاب أصدرته الجمعية المغربية لنقاد السينما حديثا تحت عنوان "حكيم بلعباس.. مشروع سينما جديدة"، عربون اعتراف من المحفل النقدي المغربي بموهبة وإبداع سينمائي يعد بالكثير.
حكاية حكيم بلعباس هي توجيه ضوء الكاميرا إلى زوايا العتمة، وتحويل المشهد الخلفي إلى صورة الواجهة، واستحضار المغيب والمحجوب واستنطاق الصامت والمسكوت ومساءلة المواقف من الهوية والذات في مراوحتها المتوترة بين الوجود بالمفرد والوجود في الجماعة.
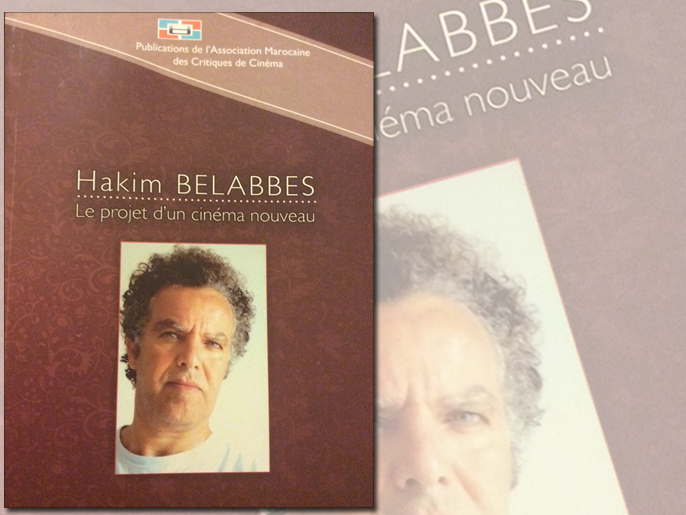
في أعماق الذات
المفارقة في مسار بلعباس هي أن الشاب الذي هاجر أولا إلى فرنسا لمواصلة دراسته العليا، ثم إلى شيكاغو بالولايات المتحدة حيث حصل على ماجستير في السينما وأصبح مدرسا لها هناك لم يعد إلى بلاده -وعلى خلاف كثيرين- من أجل إنجاز نسخ محلية للإنتاجات السينمائية الغربية بمختلف مدارسها، بل يبدو كما لو أن الاغتراب كان عامل شحن طوح به إلى أعماق تربته الجغرافية ونسيجه الاجتماعي والبنية الروحية والمجالات الطقوسية التي تختزنها هوامش البلاد وأغوارها التي لم تعتد الانكشاف على الشمس، أو لم تجد من يفعل ذلك، سينمائيا على الأقل.
مفعول الصدمة في المشهد السينمائي المغربي تحقق عام ٢٠٠٣ مع فيلمه الطويل "خيط الروح" الذي يحكي تمزق المغترب المصاب بداء عضال، والعائد في رغبة أخيرة للموت على تراب ذاكرته، تلك العودة التي تغدو فعلا انكفائيا في الزمان والمكان، وحفرا استرجاعيا في الذاكرة وذاكرة المدينة (أبو الجعد) التي ليست إلا مسقط رأس المخرج، والتي تحضر بقوة في جل أعماله.
وفي "أشلاء" الذي حاز به على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للسينما بطنجة (٢٠١١) يقدم حكيم تجربة فريدة لسينما الأنثروبولوجيا العائلية، وهو يقتفي ذاكرة أسرته الخاصة التي وثقها بالكاميرا عبر سنوات، ويضعها في قالب غير خطي متجاورة مع قصص آخرين توحدهم حالات الضياع والتهميش.
وفي "محاولة فاشلة لتعريف الحب" يقترح حكيم مادة فيلمية تجمع الوثائقي بالتخييلي، في مساءلة لا تخلو هي الأخرى من العمق الأنثروبولوجي لحقائق وأوهام هذه العاطفة، في سياقات اجتماعية مختلفة تعطيها دلالات متمايزة. وفي هذا الفيلم الأخير، يرسخ بلعباس نزوعه الصوفي لإنتاج المعرفة والفن من خلال السفر البعيد "الحج" إلى أعالي قرية أمازيغية نائية.
هي عينات من أهم الأفلام الطويلة التي أكدت من حيث مضامينها انتظام الفنان في مشروع سينمائي مسنود برؤية إبداعية وفكرية خاصة.
لكن الموضوع ليس قطعا ما يصنع فرادة تجربة سينمائية، ففي القول السينمائي سؤال الـ"كيف" أهم من سؤال الـ"ماذا".
ورغم شواهد "الالتزام" الواضحة باستكشاف قضايا الهامش بكل أبعاده، وتحرير الأصوات المكتومة في المجتمع والثقافة فإن بلعباس غير معني أساسا برفع لواء فعل فني تحريضي مباشر كسول، وهوسه بمناطق العتمة والهشاشة وقلق الكائن في شتى أوضاعه يلازمه ويسنده شغف بإسقاط الأنماط التقليدية للكتابة السينمائية، والتمرد على الجماليات النمطية.
خصوصية الأسلوب
في عقر دار الصناعة السينمائية وإنتاج المفاهيم الحديثة في الخطاب البصري لا يهم بلعباس أن يكون تلميذا مجتهدا لمدرسة أو تيار بعينه.
هو المتمكن المتابع للتراكم العالمي في نظريات السينما، لا تعني له الحداثة إلا ذلك الأفق المفتوح الذي يوسعه التجاوز المتواصل والاستفادة من الأسلوب، لا الانصياع له بما يحول الحديث إلى قالب جاهز وجامد.
| في أفلام حكيم تنهار المسافات بين الذات والآخر، بين الذات والموضوع، ولذلك فإن مشاهدة هذه الأعمال "مكلفة" وجدانيا، إذ تخرق ذات المشاهد الحاذق والمرهف الحس وتشرعها لرياح تحمل آلام الآخرين التي تصبح آلامها |
لا يشتغل حكيم بالسيناريو الجاهز كما هو متعارف عليه، نصوص سردية متوطنة في الذهن تتواصل معها الكتابة بتزامن مع الإنجاز التقني للفيلم، نص يولد نصا، شخصية تحيل إلى أخرى، فلك سردي يترابط مع آخر، رهان على الصدفة والمفاجأة، والاستعداد "الإيماني" لتوظيف "هداياها" في الدفع بالمحكي إلى منعطفات أخرى، فالتجربة الإبداعية عنده أقرب إلى سفر المريد على طريق مجهول المحطات.
تتجاور في أعمال حكيم مسارات درامية بلا روابط حكاية تقليدية يدور كل منها في سياقات متمايزة وبشخصيات مختلفة، لكن السحر الإخراجي يصنع لها فضاء للتساند وإنتاج المعنى في مكان ما، ليس إلا وعي المشاهد وحساسيته.
فأفلام حكيم بلعباس تتقاسم سمة إسقاط الوسيط، وتورط المشاهد في اشتباك شبه حي مع الخلاصة العاطفية والفكرية للمادة الفيلمية، وهو مدرك يحققه حكيم بمداخل عدة: "نمذجة" الشخصيات على المستوى الفيزيولوجي والتعبيري والسوسيوثقافي، وهي في الأغلب شخصيات من المدارات السفلى للمجتمع تحقق قدرا عاليا من المصداقية والحميمية الوجدانية والتعاطف المشارف على الانصهار، شخوص المخرج/المؤلف سليلة الألم والهشاشة، وأجسادها حوامل أمينة للحالة الوجودية والنفسية والاجتماعية، فكان أدعى أن تنكشف على الشاشة بلا مساحيق، إذ تقود الكاميرا المشاهد لأن يقتفي بإبهامه قصة الندوب والأخاديد التي حفرها الزمن على الوجوه، وأن تلفحه الأنفاس الحارة التي تتواتر بصفاء في ذلك البياض الصوتي الذي يؤثره حكيم.
وحيث تتداعى الحكايات في أفلامه بشكل أفقي مفتوح وبلا ترتيب خطي وبمجال محفوظ للارتجال فإن اللمسة السحرية للمبدع تتبلور في مرحلة التوضيب، حيث حساسية الإيقاع، وإمكانية توقيع الانتقالات المنتجة لا لحلقة درامية، بل أساسا لرسائل أثيرية وجدانية "تُحَس" و"لا تقال" بالضرورة، هي انخطافات روحية وجدانية تتحصل لدى المشاهد/الشاهد، وهو ينقاد لرحلة "حج" أقرب إلى مسارات البحث عن الأساطير الذاتية منه إلى التمتع بتجارب افتراضية أو واقعية تخص "آخرين".
في أفلام حكيم تنهار المسافات بين الذات والآخر، بين الذات والموضوع، ولذلك فإن مشاهدة هذه الأعمال "مكلفة" وجدانيا، إذ تخرق ذات المشاهد الحاذق والمرهف الحس وتشرعها لرياح تحمل آلام الآخرين التي تصبح آلامها، وأحلامهم المسجونة التي تصبح سجونا لها.
الصورة السينمائية عند بلعباس -كما يقول الناقد محمد شويكة- استطاعت أن تكون مصدر توجيه لاكتشاف آفاق وأرضيات جديدة لم تعتد عين المشاهد المغربي عليها، خاصة أنها تقترح وجهات نظر متباينة من حيث الأفكار السائدة وأحكام القيمة الجاهزة التي ترتبط بها.
كما أنها صورة تجعله -حسب الناقد محمد البوعيادي- واحدا من المخرجين المغاربة القلائل الذين لهم فهم واضح للممارسة السينمائية، بل مشروع متكامل ينبني على جعل السينما فعل وجود إنساني ينطلق من الإنسان وإلى الإنسان بهدف إسماع صوته خارج حدود الزمان والمكان.