مصداقية "الإعلام البديل"!
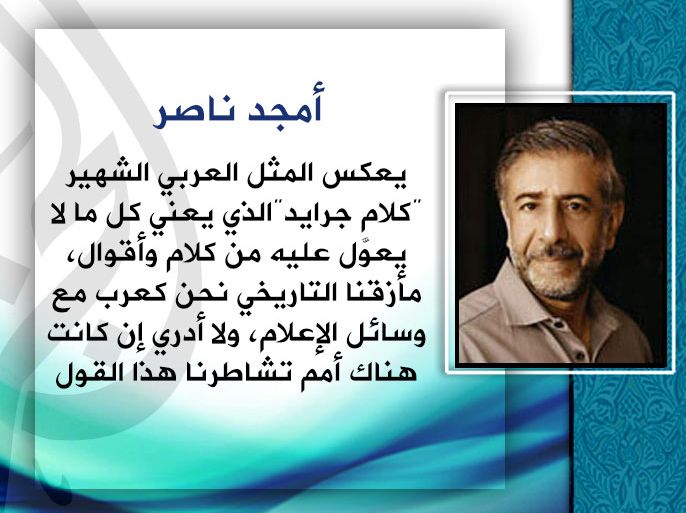
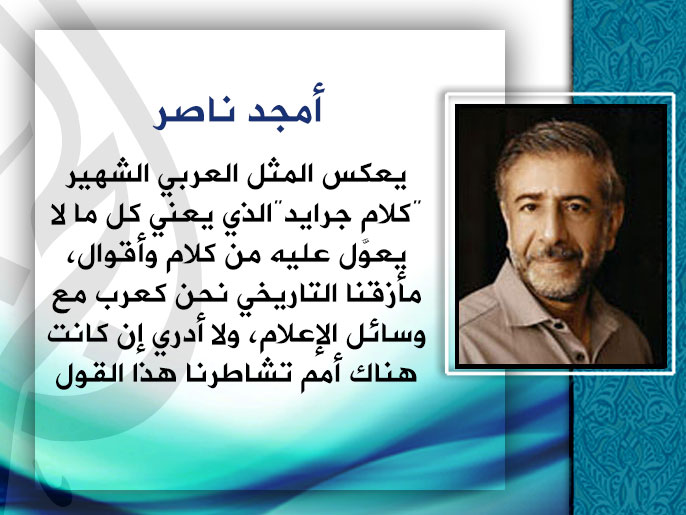
فـ"المصداقية" ترتبط في الذهن الجمعي-على ما يبدو- بما هو مجرب ومألوف من المواد والقوالب، أما ما هو غير مألوف ومتعدد فيدعو إلى الحذر، إن لم يكن إلى الريبة والشك. الناس يألفون -حسب ظني- ما يعرفون، حتى وإن كانوا يعلمون أن هذه "الألفة" ليست معيارا للصدق أو الحقيقة.
هذا ما يفعله، مثلا، الإعلام الرسمي السوري. فهو يتبنى رواية منفصلة عن الواقع السوري وما يحفل به من صراعات. هذا الإعلام يعرف أنه يكذب ويلفِّق، ولكنه يعتمد على عنصر "الألفة" وخوف جمهوره من التعرف على رواية أخرى للواقع.
لنعد قليلا إلى الوراء.. كثيرون منا يتذكرون ولادة التلفزيون وما أحدثه من تغير جذري في طبيعة المادة الإعلامية، وما مارسه من تأثير كاسح على جمهورٍ فاق في وقت قصير مستمعي الراديو وقراء الصحف والمجلات وما شابه ذلك من وسائط "تقليدية".
وأكثر من السابقين يتذكرون ولادة البث الفضائي الذي حوّل العالم إلى "قرية صغيرة" من خلال وجوده في التو واللحظة في مكان الحدث، ونقل ما يجري هناك مباشرة إلى جمهور يتوزع على قارات تفصل بينها بحار ومحيطات. لم يكن العالم "صغيرا" و"قريبا" مثلما بدا عليه في الفضائية العابرة للحدود والقوميات.
| لا أعرف كيف ستكون الثورة السورية، تحديدا، لولا تكنولوجيا الاتصالات الحديثة التي كسرت احتكار النظام للمعلومة والصورة، وجعلت السياج الحديدي الذي فرضه على وسائل الإعلام العربية والأجنبية بلا معنى |
بعد البث الفضائي الذي ربط العالم بعضه ببعض جاءت ثورة الإنترنت. هنا خطت التكنولوجيا -حسبما قلت في مقال سابق في هذا المنبر- خطوة هائلة (بألف مما يعدّون) في اتجاه ملايين الناس، الذين كانوا حتى تلك اللحظة مجرد متلقين للمواد الإخبارية والفنية والثقافية.
مع هذه الخطوة الهائلة صار "الطرف الآخر" من المعادلة الإعلامية -المتلقي شبه السلبي- طرفا في صنع المعادلة نفسها، ولم تعد الساحة حكرا على "المحترفين" الذين توكل إليهم صناعة الخبر والصورة.
كثيرون -أكثر بكثير من السابقين- يتذكرون ما قامت به "وسائل التواصل الاجتماعي" في معركة أوباما للوصول إلى "البيت الأبيض". فقد تكون تلك أول انتخابات أميركية، بل عالمية، تدخل فيها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة معركة السباق الانتخابي على نحو حاسم. كانت التلفزة ووسائل الدعاية التقليدية (الإعلانات والصحف والمجلات والملصقات والمهرجانات) هي الوسائط الإعلامية الأبرز في صراع المرشحين الأميركيين إلى الرئاسة.
التلفزة لعبت دورا مهما في صعود جورج بوش الابن في دروتيه الانتخابيتين. التخويف من "الآخر" والشعور الإمبراطوري الأميركي المتضخّم وتران رنّا بقوة في تلك المعزوفة الشعبوية، خصوصا في دورته الرئاسية الثانية. وقد وقفت محطات التلفزة الشعبية (فوكس نيوز مثلا) التي تحظى بأعلى نسبة مشاهدة في أوساط الطبقات الشعبية الأميركية إلى جانب مرشح الحزب الجمهوري.
كان العراق وهواجس الأمن والوطنية الأميركية، وليست السياسات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية الداخلية، هي النغمات المفضلة لتلك التلفزة ذات التوجه اليميني الشعبوي. وإذا عرفنا أن الشاشات الأكثر مشاهدة في البيت الأميركي العادي مملوكة لتايكون الإعلام، الأسترالي روبرت مردوخ، لن يطول عجبنا. فهو صنع شيئا مماثلا في بريطانيا، عندما استحوذ على وسائل الإعلام الشعبوية، قبل أن يوسع نشاطه وراء الأطلسي.
لكن عنصرا تعبويا لم يكن في حسبان خصوم أوباما، دخل على خط المعركة إلى البيت الأبيض: إنها وسائل الاتصال الاجتماعي. وهذه وسائل إعلام واتصال شبابية بامتياز. قوة الزخم في حملة باراك أوباما الأولى (كمثال ساطع على دور وسائط التواصل الاجتماعي) لم تكن ممثلة في الطبقة الوسطى والولايات ذات التقاليد الديمقراطية فقط، بل في الشباب.
هؤلاء هم سادة "الإعلام الموازي" على الشبكة العنكبوتية وتكنولوجيا الاتصالات. إنهم الأبناء الشرعيون لزمن الإيميل، وفيسبوك، وماي سبيس، ويوتيوب، وتوتير، وما شابه ذلك من وسائل توفرها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في كل يد، وفي كل بيت تقريبا.
| لوقت طويل كانت وسائل الإعلام "مستقرة" ومألوفة، ولم تخضع إلى تغيرات كبرى.. وليس هذا حال أيامنا الحاضرة التي تعيش على الإيقاع اللاهث لثورة تكنولوجيا الاتصالات |
ثم.. جاء "الربيع الإيراني" الموؤود، لتكون وسائط التواصل الاجتماعي سلاحا رائدا، لأول مرة بالعالم الثالث، في أيدي أنصار المرشح الرئاسي مير حسين موسوي في الحشد والتعبئة ونشر المعلومة التي لا تجد طريقا إلى وسائط الإعلام الرسمية أو شبه الرسمية.. وهذه الوسائط الجديدة التي وفرتها -على نحو حتمي- تكنولوجيا الاتصالات، بقصد أو من دون قصد، هي التي جعلت، لاحقا، الثورتين التونسية والمصرية ممكنتين.
في كل تلك الخطى والمراحل التي مرت بها وسائل الإعلام ظل سؤال المصداقية قائما. ولعل أبلغ تمثيل على هذا السؤال يختصره القول الشعبي العربي الشهير "كلام جرايد" الذي يعني كل ما لا يعوَّل عليه من كلام وأقوال.
ولا أدري إن كانت هناك أمم تشاطرنا هذا القول الذي يعكس مأزقنا التاريخي، نحن العرب، مع وسائل الإعلام التي ظلت، لوقت طويل، مملوكة كليا من قبل الأنظمة.. ولم يطرأ تغير جزئي على هذه المعادلة إلا في العقدين الأخيرين.
في "منتدى الفجيرة الإعلامي" الذي انعقد مؤخرا كان سؤال المصداقية مطروحا على الإعلام بشقيه "التقليدي" و"الجديد"، لكن نبرة التشكيك شملت "الجديد" وبدا أن التشكيك يزداد طردا مع سنِّ المشاركين أو المتدخلين من أفراد الجمهور الذين غصت بهم قاعة المنتدى.
ورغم أن عنوان واحدة من الندوات التي خصصت لمصداقية وسائل الاتصال الاجتماعي بدا محايدا، فإنه انطوى -في العمق- على نبرة تشكيك بصدقية ما تضخه هذه الوسائل من معلومات. ونبرة التشكيك هذه قادمة من مفهوم "الألفة" الذي أشرت إليه في مستهل هذا المقال.
| رغم أهمية سؤال المصداقية المطروح على مثل هذه المواد المتدفقة عبر وسائط غير "تقليدية" وعلى الأغلب غير مهنية، فإنه يظل -بالنسبة لي- سؤالا ثانويا أمام بحر الدم الذي أغرق فيه النظام السوري شعبه وبلاده |
لوقت طويل كانت وسائل الإعلام "مستقرة" ومألوفة، ولم تخضع إلى تغيرات كبرى.. وليس هذا حال أيامنا الحاضرة التي تعيش على الإيقاع اللاهث لثورة تكنولوجيا الاتصالات حتى ليبدو أنه لا حدود لهذه الاندفاعة المحمومة. فإذا ألقينا نظرة سريعة على هواتفنا المحمولة التي كانت بين أيدينا قبل عامين ندرك كم هو عمرها قصير وكم هو سريع تحولها إلى مستحثات تكنولوجية.
ليست التغيرات، هنا، شكلية أو ديكورية، بل تشمل البرامج التي تجعل من الهاتف المحمول جهازا متعدد الوسائط وبكفاءة لا تقل عما هي عليه تلك الوسائط منفردة. يكفي أن نعرف أن هناك مهرجانات ومسابقات سينمائية لأفلام الهاتف المحمول!
وفي ضوء ما تقدَّم، لا أعرف كيف ستكون الثورة السورية، تحديدا، لولا تكنولوجيا الاتصالات الحديثة التي كسرت احتكار النظام للمعلومة والصورة، وجعلت السياج الحديدي الذي فرضه على وسائل الإعلام العربية والأجنبية بلا معنى.
فقد تمكن النشطاء السوريون و"المواطنون الصحافيون"، كما بتنا نعرف اليوم، من تأمين تدفق رهيب للصور والمعلومات عبر أجهزة الهاتف المحمول وضخها لوسائل الإعلام العربية والأجنبية مباشرة أو تحميلها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى عكس الثورات العربية السابقة عليها، شكلت وسائل التواصل الاجتماعي الوسيط الحاسم لنقل ما يجري في سوريا، وصارت مواد النشطاء السوريين الإعلامية أكثر احترافا ودقة (ما أمكن ذلك) بفضل الخبرات التي توفرت لهم على مدار عامين دمويين من عمر الثورة السورية، ولكن هذا لا يعني أن كل ما يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للثورة السورية يمكن أخذه على عواهنه، فلا بدَّ من التدقيق فيه والتثبت من صدقيته.
وهذا ما تفعله بعض التلفزات الفضائية العربية أو التي تبث باللغة العربية، ولكن حتى وسائل الإعلام التابعة لدول وقوى ليست مؤيدة للثورة السورية تجد نفسها مضطرة لاستخدام مواد النشطاء السوريين الإعلامية لأن النظام السوري لم يسمح بوجود بديل مستقل ومهني لها.
ورغم أهمية سؤال المصداقية المطروح على مثل هذه المواد المتدفقة عبر وسائط غير "تقليدية" وعلى الأغلب غير مهنية، فإنه يظل -بالنسبة لي- سؤالا ثانويا أمام بحر الدم الذي أغرق فيه النظام السوري شعبه وبلاده. فهناك شبان سوريون قتلوا وجرحوا وغيبوا وراء الشمس كي يوفروا لنا هذا الفيض الغامر من الصور والمعلومات التي نتساءل، في مكاتبنا الآمنة والمكيفة، عن مدى صدقيتها!